يا رَبِّ طُرقَكَ عَرِّفْني و سُبُلَكَ علِّمْني ( مز 25 /4)
دعوة الى التوبة - جنود مريم
دعـــــوة إلـــى التوبـــــة

تُعنى بطبعه ونشره جمعيّة «جنود مريم»
علم وخبر 167/أ د - لبنان
يُوزَّع مجّانًا
عالمنا اليوم
يشهد العالم اليوم، ومنذ سنوات عديدة، تغيّرات اجتماعيّة وأخلاقيّة خطيرة؛ تتجلّى بظهور واسع لتيّارات فكريّة وروحيّة غريبة، تبلبل النفوس وتضرب الإيمان وتزعزع بقوّة أركان المجتمعات البشريّة، خصوصًا المسيحيّة. إضافة إلى انتشار واسع للكثير من البدع والهرطقات في كلّ مكان، تجرف معها ضعفاء النفوس من مختلف الأديان والاتجاهات والطبقات والأعمار.
يرافق هذه التيّارات الإلحاديّة المنحرفة، إنفلات أخلاقيّ يضرب العالم، ويتسلّل إلى مجتمعاتنا ورعايانا، عبر مختلف الوسائل الإعلاميّة؛ وما أكثرها اليوم منها التلفزيون (الدش) والسينما وبعض المجلاّت بالإضافة إلى الانترنيت. تبثّ سمومها في كلّ مكان، وتهدّد بسقوط ما بقي من قيمٍ روحيّة واجتماعيّة وأخلاقيّة؛بعد ما مهّد لذلك، الفتور في الإيمان وعدم الوعي والثقافة الروحيّة، إلى الاستهتار في عيش وصايا الله وتعاليم الكنيسة، وفي ممارستنا المشوّهة للأسرار المقدّسة.
وما تشريع الإجهاض (قتل الجنين)، وتشريع الزواج المثلي (رجل من رجل وامرأة من امرأة) وغيرها... إلاّ دليل ساطع على المستوى الروحيّ والاجتماعيّ، الذي وصلت إليه أنظمة بعض الدول الكبرى التي تتدّعي المسيحيّة والحضارة؛ وذلك رغم رفض الكنيسة ومعارضتها الشديدة والصارمة لها. فأيّة حضارة تقتل الجنين وتخالف الطبيعة البشريّة؟!...
فقدان المحبّة
أضف إلى ذلك، الاضطرابات الأمنيّة التي تلفّ العالم، بسبب فقدان السلام والمحبّة في نفوس زعماء العالم. فبدل أن يهتمّوا بأولويّات شعوبهم، من معالجة الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والمعيشيّة، التي أدّت إلى الفقر والجوع الذي يقضي على الكثيرين في الدول النامية، فملايين من البشر يموتون سنويًّا من الجوع، والبطالة تتفاقم سنة بعد سنة؛ إنّهم يتسابقون إلى التسلّح وامتلاك أسلحة الدمار والأسلحة النوويّة الفتّاكة، التي إذا ما استُعملت قضت على العالم بأسره. والجدير بالذكر، هو الانتشار الواسع للمجموعات الأصوليّة والإرهابيّة المنتشرة في كثير من دول العالم، تثير الاضطرابات وتهدّد بكلّ لحظة السلام والطمأنينة والحياة الطبيعيّة.
نستطيع القول، إنّ العالم للأسف يمرّ بأسوأ مرحلة من تاريخه الحديث. من حيث تعاظم الشرّ والفساد، وحيث لم يعد للمحبّة مكان في النفوس؛ بعدما سيطرت روح المادّة والأنانيّة وعبادة المال والسلطة، وحلّت محل روح الأخوّة . إنّنا نعيش، ومنذ زمن بعيد، في عصر انحطاط روحيّ واجتماعيّ وأخلاقيّ، في عصر تمارَس فيه الخطيئة والفساد بكلّ بساطة ودون رادع، وكأنّ شيئًا لا يحصل. لقد اتّسعت وعمقت الهوّة بين الله وشعبه. فبدل التسابق إلى بناء حضارة المحبّة والسلام، أي حضارة السماء والإنجيل والبشارة، وجهّت الطاقات لفعل المعصية والاتجاه بها نحو حضارة الموت بمختلف وجوهها البشعة؛ والتي لا تؤدّي إلاّ إلى الدمار وموت النفس والهلاك الأبديّ.
فكيف السبيل أيّها الإخوة إلى السلام والخير والعيش بحضور الله، وروح الإلحاد والعلمنة والإباحيّة والإنفلات والفجور والخلاعة والإنغماس في الملذّات الأرضيّة الدنيويّة، أصبحوا هدف الكثيرين، وحلّوا محلّ المحبّة والتواضع والتجرّد والتقشّف وفعل الإماتة وحمل الصليب وعيش الأسرار والصلاة. خاصّة في أوساط الشبيبة الضائعة المضطرّبة، والمنشغلة بأفكار ثورويّة، في العنف والجنس والمخدّرات. وهم الملقى على عاتقهم مستقبل الوطن والكنيسة.
فأيّ مستقبل للوطن والكنيسة على هذه الحال؟ وأين دور المدارس والجامعات في توعية هؤلاء الشباب، خصوصاً بعدما قلّت فيها ساعات التعليم المسيحيّ إن لم نقل انعدمت!

الكنيسة اليوم
وما يجب التوقّف عنده أيضًا، هو الوجود القويّ لبعض البدع داخل الكنيسة، التي يحاول أصحابها جاهدين بكلّ الوسائل الماديّة والترغيبيّة بتشكيك المؤمنين بإيمانهم، عبر بثّ تعاليمهم المغلوطة وأفكارهم المنحرفة التي تناقض تعليم الكنيسة "الجامعة المقدّسة والرسوليّة" ، محاولين عن قصد وعن غير قصد، تضليل أكبر عدد ممكن من النفوس، بعد تشكيكهم بإيمانهم؛ إيمان الآباء والأجداد الذي أثمر عبر الأجيال قوافل من القدّيسين، ألا وهم الكواكب الساطعة في سماء الكنيسة، والذين ثبّتوا بوضوح صحّة تعاليمها.تحدث هذه الأمور كلّها، رغم خطورتها على الإيمان والنفوس، فيما نحن منشغلون في خلافات سياسيّة لا جدوى منها؛ لا بل تمعن في شرذمة صفوفنا وتضرب وحدتنا وتماسكنا، وتؤدّي إلى تفكّكنا وإضعافنا.
إنّ الكنيسة اليوم في العالم، تمرّ بمرحلة صعبة وخطيرة، وتُشَنّ عليها حربًا قويّة من الداخل والخارج. فكلّنا يسمع ماذا يحصل لمسيحيّي بعض الدول، المهدّدين بوجودهم ومستقبلهم، وهذا أمر خطير إذا ما توقّفنا عنده جيّدًا؛ رغم أنّه ليس جديدًا على الكنيسة، فمنذ نشأتها وهي تقريبًا، تعيش حياة اضطهاد دائم، وأوّل المضطهدين هو معلّمها يسوع المسيح، وهو من قال: "سيضطهدونكم من أجل اسمي. ولن يغيب عنّا كلامه أيضًا: "إنّها على الصخر وأبواب الجحيم لن تقوى عليها".
خطر تفكّك العائلة
أمّا العائلة، وهي أساس الكنيسة والمجتمع، هي أيضًا تُضطهَد وتعاني في الصميم خطر التفكّك والانهيار، وكَثُرت في أيّامنا العوامل التي تضرب أسسها ومكوّناتها، منها على سبيل المثال الزواج غير الكنسيّ (الزواج المدنيّ وغيره) الذي يحرُم الزواج من قدسيّته، ويعرّضه للتفكّك حسب المزاجيّة والأهواء. والمساكنة وعدم الالتزام يحرّر الرجال والنساء من واجباتهم والتزاماتهم العائليّة. والخيانة المتبادلة للأزواج، يهدّد العائلة فيضيع الأولاد ويتركون بيوتهم في عمر مبكر، خصوصًا بسبب موجات التحرّر التي تضرب الغرب وبدأنا نتلمّسها.
إضافة إلى الاتجاه العام إلى عدم الإنجاب والإجهاض، وكلّ هذه الأمور بدأت ملامحها تظهر في مجتمعاتنا. وما يزيد في انتشارها، بعض وسائل الإعلام خصوصًا المرئيّ، الذي من خلال بعض البرامج يبيح الزنى والخيانة والتحرّر والانفلات والمساكنة...، مما لذلك من تأثير سلبيّ كبير على تماسك العائلة. أصبحنا نقلّد كلّ ما نرى ونسمع دون وعي ودون انتقاء وتميّز، ونستورد كلّ ما هو فاسد للأسف.
وقفة تأمّل
أيّها الإخوة، ليس الهدف من عرض هذا الواقع السلبيّ، والمستقبل المظلم الذي ينتظر العالم، إلاّ لكي نتوقّف عنده جميعنا، ونتأمّل به، وندرك مدى ابتعادنا عن جوهر وجودنا، ألا وهو نشر المحبّة والسلام وإظهار صورة المسيح الحقيقيّة، لنكون شهودًا أُمناء لمن خلقنا وافتدانا. والهدف أيضًا، هو معرفة مدى ضلالنا وانحرافنا عن الطريق الصحيح، الذي رسمه لنا يسوع من خلال إنجيله، وأرادنا أن نسلكه. فيكون هذا الواقع المؤلم، حافزًا يدفعنا مجدّدًا لالتماس رحمة الله، الذي ينتظر عودتنا بفارغ الصبر. فلا سلام ولا خلاص إلاّ بيسوع المسيح "الطريق والحقّ والحياة".
000فهلاّ وقفنا أيها الإخوة، وقفة ضمير حيّ وواعٍ، تجاه مسؤوليّاتنا أمام هذه التغيّرات الخطيرة التي تعصف بالعالم، وهذا الإنهيار المريع في الأخلاق؛ وهلاّ فكّرنا بموضوعيّة في مستقبل أولادنا، دون أن نلقي التُّهم واللوم على بعضنا البعض؟! فكلّنا مسؤولين، رجال دين وعلمانيّين، فلا يسمحنّ أحدٌ لنفسه بالتنصّل من المسؤوليّة. لنوحّد جهودنا ونسير معًا يدًا واحدة ملتزمين العيش في حياة الكنيسة "الأم والمعلّمة"، مواظبين على الصلاة، والله يستجيب صلاة الجماعة.

صرخة ألم
وانطلاقًا من هذا الواقع السيّئ، كان لا بُدّ لنا من أن نطلق صرخة تهزّ الضمائر والقلوب. صرخة صدّ وردع لكلّ هذه الميول الشريرة، التي تنخر بقوّة جميع المجتمعات البشريّة وخصوصًا مجتمعنا المسيحيّ. صرخة ثورة وانتفاضة على الشرّ والفساد، وأخيرًا صرخة تحسّر على أنفسنا ممّا ينتظرها.
هذه الصرخة نطلقها من أعماق قلوبنا، ونودّها أن تدخل إلى أعماقكم أيضًا بكلّ محبّة وغيرة مسيحيّة صادقة. فلنتذكّر معًا صرخة الربّ لقايين "ماذا فعلت بأخيك"؟! وصرخات الحبّ والحزن معًا التي يطلقها يسوع المتألّم المعلّق على الصليب أبدًا بسبب معاصينا:
ماذا فعلتم بمسيحيّتكم ومعموديّتكم؟!
ماذا فعلتم بصورة الله فيكم؟! وماذا فعلتم بوزناتكم؟!
لكن للأسف، هذه الصرخات لا يسمعها الكثيرون، لأنّ الخطيئة التي أصبحنا عبيدًا لها، صمّت آذاننا، وغشت عيوننا، فبتنا لا نسمع كلام الله ولا نشاهد نوره. وإذا ما سمعناه، فنعيشه بحسب أهوائنا وفلسفتنا وعلى طريقتنا. فنفسّر كلام الله في الإنجيل وتعاليم الكنيسة بحسب ما يحلو لنا وبحسب ما يتوافق مع طريقة عيشنا ومبادئنا. ولكن هذا الفادي لم يتركنا، وهو حاضر دومًا ليغفر لنا، وهنا صرخته الأكثر محبّة على الصليب: "اغفر لهم يا أبتِ لأنّهم لا يدرون ماذا يفعلون".

المسيحيّة في الأمس واليوم
وفي مقارنة بسيطة بين مسيحيّي الأمس ومسيحيّي اليوم، يظهر لنا الفرق الشاسع. لقد عاش المسيحيّون الأوائل حياة اضطهاد وعذاب دائم، وكانت دماء الشهداء ثمن وجودنا اليوم، حملوا الصليب بفرح طيلة أجيال واستشهدوا، لتبقى المسيحيّة رمزًا للشهادة والمحبّة والعطاء والسلام شاهدة على حبّ الله. وما تميّز به أجدادنا هو عمق إيمانهم وصلابته، جاهروا به دون خوف لأنّهم مدركون تمامًا أنّه حقّ. كانوا متماسكين وعائلة واحدة، يجمعهم إنجيل الله ووصاياه وتعاليم الكنيسة المقدّسة. كانوا رمزًا للوحدة والإلفة "أنظروا كم يحبّون بعضهم البعض" (أعمال الرسل).
كانوا فعلاً شهود حقّ، حملوا الكلمة وكان عهدًا عليهم أن يوصلوها بأمانة إلى أولادهم وأحفادهم، لا بل كان واجبًا عليهم أن يغنوها أكثر بدورهم.
هل نعمل نحن على أن تصل أيضًا إلى أولادنا وأحفادنا؟!
فبعدما فقدنا الحرارة في إيماننا، بدأت قيمنا المسيحيّة الروحيّة والإنسانيّة، تذوب أمام أعيننا يومًا بعد يوم وكأنّ شيئًا لم يحصل!
فهل نحافظ على المسيحيّة بمخالفة وصايا الله والكنيسة؟!
هل نحافظ على المسيحيّة باستخفافنا بالقيم والأخلاق، وبارتكابنا الخطيئة بكلّ استهتار وبساطة؟!
وهل نحافظ على المسيحيّة باستباحة القتل والزنى والسرقة والبغض والحسد والغيرة، وكلّ ما هنالك من خطايا شنيعة ومكروهة؟!
هل نحافظ على المسيحيّة بعبادتنا مئات ومئات الأصنام الأرضيّة، وتركنا لخالقنا الذي أحبّنا وضحّى بابنه الوحيد لخلاصنا؟!
هل نحافظ على المسيحيّة بهتك القدسيّات، والكفر المباشر والغير مباشر بالتعاليم الإلهيّة والاستخفاف بالأسرار المقدّسة؟!

هل نعيش الأسرار؟
ولنتوقّف عند هذه العطيّة الكبيرة المجانية وهي الأسرار المقدّسة: القربان (الإفخارستيّا)، الكهنوت، المعموديّة، التثبيت، الزواج، التوبة ومسحة المرضى. فهل نعلم أنّها علامة حضور الله الحيّ بيننا. وأنّها استمراريّة لحياة الكنيسة في كلّ مرحلة من مراحل حياتنا، وأنّها تجسّد محبّة الله الكبيرة وتضحية الابن وحضور الروح القدس الدائم؟! وهل ندرك قيمتها وأهميّتها في حياتنا الروحيّة اليوميّة؟!
الجواب هو: لا!
فسرّ القربان، هو محور الأسرار كلّها، هو أرفع سرّ بين الأسرار، هو ذبيحة المسيح نفسها، أعظم من كلّ ذبائح الأرض وينبوع كلّ النِّعَم، تتفجر فيه المحبّة اللامتناهية والتضحية المطلقة، "هل هناك محبّة أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبّائه". هل ندرك عند تناولنا القربان المقدّس، إنّه فعلاً جسد المسيح يتجدّد فينا من ألفي سنة حتّى اليوم؟! وهل ندرك قيمته وعمله فينا؟ وهل نتقدم منه بخشوع وتوبة وبمظهر لائق ومحتشم يليق بهذا السرّ العظيم؟!
قليلون جدًّا الذين يفعلون، وكثيرون لا يدخلون بيت الله إلاّ في مناسبات نادرة (حزن أو فرح). هل يُعقل أن نصل إلى هذا الحدّ؟! نخجل أن نقول أنّ الذبيحة الإلهيّة أصبحت عند الكثيرين احتفالاً روتينيًّا يضجر وذكرى تتكرّر! لقد أصبحت أعيادنا واحتفالاتنا الليتورجيّة، خصوصًا الأعراس والعمادات، مناسبات للأكل والشرب والمآدب والسكر وعرض الأزياء الخلاعيّة؛ فيها يُشتم الله ويُهان. إضافة إلى مظاهر البذخ والترف التي ترافق بعض هذه الاحتفالات، دون مشاركة الفقراء والمعوزين وما أكثرهم اليوم. فبدل أن تكون هذه المناسبات مصدر بركة ونعمة من السماء، أصبحت مصدر نقمة علينا؛ نتعامل معها بسطحيّة مفرطة ونمارسها بجهل، فتصبح عديمة الثمار الروحيّة وفارغة الجوهر.

وسرّ التوبة،
وهو سرّ المصالحة، يُجسّد به الله محبّته وتسامحه وغفرانه ورحمته وحنانه للبشر. هل نُقدم عليه ونمارسه بكلّ إيمان بأهميّته، مدركين فعلاً أنّه باب الرجوع إلى الله؟ وهل نتقدّم نحوه بتوبة كاملة لننال الغفران الكامل؟! كيف! ولنذهب أبعد من ذلك إذ يوجد بيننا من يدّعون المسيحيّة، وهم في الحقيقة أصحاب بدع، يقولون إنّه لا حاجة للاعتراف أمام الكاهن. أليس هذا نقض فاضح لهذا السرّ؟! فالكاهن هو ممثّل المسيح على الأرض وله سلطان غفران الخطايا باسمه، "مهما تحلّه في الأرض يكون محلولاً في السماء وما تربطه في الأرض يكون مربوطًا في السماء"(متى:16/19). وبالتالي لا تُغفر الخطايا إلاّ بواسطة الكاهن.

وماذا عن سرّ الزواج والعماد ومسحة المرضى
، تلك الأسرار لا تقلّ بأهميّتها وجوهرها عن سرّ القربان وسرّ التوبة. إنّنا إذا مارسناها فبدون تعمّق في جوهرها وكأنّها عادات وتقاليد قديمة و"فولكلور" نحملها مع الأيّام، غير مدركين أنّها مصدر نِعَم غزيرة ننالها عندما نعيشها ونفهم مدى أهميّتها؛ ونفقدها عندما نفقد احترامنا وخضوعنا لها عن صميم إيمان حقيقيّ بمدى فاعليّتها، ونفقد الإيمان بقدرتها على إعطائنا نِعمًا روحيّة نسلك بها في الحياة الروحيّة الصحيحة.
نتيجة الإهمال
لقد أهملنا كلّ الخيرات والنعم السماويّة التي ننالها بالأسرار، وتعاملنا معها بجهل مفرط. وبسبب عفوتنا واستهتارنا، وعدم سهرنا على القيم، سمحنا دون أن ندري لأصحاب البدع والأفكار المشكّكة (شهود يهوه، ومن يطعن ببتوليّة مريم وغيرهم...) من التغلغل بيننا بسهولة ورمي سمومهم في رعايانا ومجتمعاتنا، ممّا أدّى إلى تشكيك الكثيرين. وهذا ما يسبّب لنا الحزن لا على الكنيسة،
فهي "على الصخر وأبواب الجحيم لن تقوى عليها"(متى16/18)، بل على النفوس المنجرّة وراء تلك الأضاليل. وكلّنا مسؤولون، فالسبب الأوّل هو مثلنا السيّئ والوقوف حجر عثرة من خلال عدم عيشنا الصحيح لإيماننا، وعدم شهادتنا لمحبّة الله لنا ولمسيحيّتنا. فلم نكن "الخميرة في العجين! ولا الملح في الطعام! ولا السراج في الظلمة! ولا نور العالم"...
بعد التأمّل في كلّ هذه الأمور، يظهر لنا بوضوح مدى الخطأ والإنجراف اللذين نعيش فيهما، ومدى خطورة ما أوصلنا إليه هذا المسلك الرديء.
دعوة صادقة
لذلك ندعوكم إلى توبة حقيقيّة، إلى مراجعة الذات والتوقّف عند هذا الأمر بجديّة مطلقة. لأنّ خلاص نفوسنا على المحك، وهل هناك أهمّ من الخلاص يطمح إليه كلّ مسيحيّ. خلاصنا بأيدينا فمن الغباء أن نتغاضى عن العمل من أجله.
لنرذل الخطيئة، ولا ندع الشيطان ينتصر علينا بأفكاره وميوله الشريرة، لأنّ هدفه تدمير كلّ ما هو من الله. وخصوصًا النفس البشريّة. ألسنا أهمّ مخلوقات الله وأعزّها إلى قلبه؟ ألم يدفع دم ابنه الوحيد ثمنًا لخلاصنا؟ لذلك، أصبحنا نحن الشغل الشاغل لإبليس، وعمله باختصار زرع الشرّ والفساد والحروب في العالم. إذن فلنقطع أسلاكه، ولنسلك فقط طريق يسوع باتباع وصايا الله وتعاليم الكنيسة المعصومة عن الخطأ، ولنبتعد عن كلّ إغراءات الخطيئة، فننال بذلك الحياة الأبديّة والسعادة التي لا نهاية لها بقرب خالقنا. أليس هذا أسمى رجاء في المسيحيّة؟!
والكلّ يعرف نهاية من يسلك طرق الشرّ، وينغمس في الملذّات والميول الطائشة والشهوات الدنيئة. فهل نخسر حياة أبديّة من السعادة بسبب لذّة عابرة وسعادة مزيفة ، ونُلقى في جهنّم حيث نارها لا تنطفئ ونبقى فيها إلى الأبد؟! أو نتحمّل سماع هذه العبارة: "اغربوا عنّي يا ملاعين إلى النار المؤبّدة"؟! فماذا نختار وكلّ هذه الحقائق واضحة أمامنا وضوح الشمس. ولا نظن أنّ أحدًا سيصل إلى هذا الإجرام بحقّ نفسه حتّى يُقدم على إهلاكها. إنّه لمن الجهل والغباء وذروة الاستهتار بالنفس.
إذن لنتب توبة كاملة عن قصد عدم الرجوع إلى الخطيئة ثانية، واليوم قبل الغدّ فالله رحوم غفور. كما استقبل الأب ابنه الضال العائد إليه بفرح كبير، هكذا الآب السماويّ ينتظر كلّ خاطئ يرتدّ، وكلّ ضال يعود ليستقبله بفرح عظيم مع ملائكته وقدّيسيه شفعائنا.
فلنسرع في توبتنا الصادقة، لأنّه "لا نعرف متى يأتي ربّ البيت، يجب أن نكون مستعدّين لئلاّ يأتي ويجدنا نيام". "ولنمشِ في النور ما دام لنا النور لئلا يدركنا الظلام". أليست هذه أقوال يسوع؟ لماذا نصمّ آذاننا عن سماعها ولا نتأمّل بها؟ مهما تكن خطايانا كثيرة، المهمّ التوبة الصادقة: "توبوا إليّ فأتوب إليكم" (العهد القديم). ومثلنا في هذا توبة مريم المجدليّة الصادقة، التي حصلت على الغفران الكامل لجميع خطاياها لأنّها أحبّت كثيرًا، ولكن يسوع طلب منها ألاّ تعود إلى الخطيئة ثانية.

الربّ ينتظرتوبتنا
ولا نظن أنفسنا متأخّرين أو فات الأوان. لنتبّ بحقّ فنحصل على الغفران، ومثلنا في هذا توبة اللص اليمين الذي نال الغفران بآخر لحظة من حياته، لأنّ توبته كانت صادقة. وأيضًا مثل الأجير الذي أتى متأخّرًا للعمل ونال أجرًا كاملاً. كلّ هذا يقوّي رجاءنا، ولنقيم بيننا وبين الله عهدًا بأنّنا لن نعود إلى الخطيئة. والله صاحب الحبّ الكبير لا يريد هلاكنا. فقد أرسل وحيده ليخلّص العالم، لا ليدينه. أفلسنا أبناءه! وخلقنا على صورته ومثاله؟ أليست فينا روحه؟ لنحافظ على كلّ نعمه هذه وعطاياه المجانية، ولنتذكّر عهده مع البشر منذ بدء الزمان إلى اليوم.
ففي البدء أرسل الأنبياء ليهدوا شعبه ويمهّدوا الطريق أمامه، ثمّ في ملء الزمان أرسل ابنه الوحيد ذبيحة لخلاصهم، ليرفعهم عن الخطيئة والموت الأبديّ نحو الملكوت الذي أعدّه لهم منذ إنشاء العالم. والقدّيسون شفعاؤنا لدى الله هم من ثمار هذه الذبيحة، يحملون رسالته ذاتها لبني البشر. وفي طليعتهم أمّنا العذراء مريم الحنونة والغيورة على خلاصنا، فهي شفيعتنا الأولى لدى الله، والمشاركة بقوّة في سرّ الفداء مع ابنها يسوع المسيح فادينا.

رسالة مريم
وما ظهوراتها في مختلف بقاع الأرض، إلاّ تكملة لهذه الرسالة التي تدعو للمحبّة والتوبة والصلاة وفعل الإماتة ونبذ الخطيئة بكلّ أشكالها. فلنتقدّم منها بكلّ ثقة وبدون تردّد، لأنّها الشفيعة القديرة لدى الله، ملتمسين منها العون والنِّعَم، سالكين بواسطتها طريق الخلاص. إنّها الأم الحنون التي تتألّم لأجل أولادها الذين يتقدّمون بأنفسهم نحو الهاوية. كلّنا أولادها وهي تحملنا في قلبها وصلاتها، فلنطلب شفاعتها خصوصاًَ بتلاوة المسبحة الوردية هذه الصلاة العجائبيّة بشهادة كل من تلاها بإيمان وتقوى والتي أوصلت كثيرين إلى القداسة. وهي بدورها تقدّم طلباتنا إلى الثالوث الأقدس وهو يعطينا ما يتوافق مع خلاصنا ومصلحتنا الروحيّة.
والعذراء أيضًا هي أمّ الكنيسة، تقودنا إليها دائمًا لأنّها مصدر كلّ النِّعَم وكلّ الخير، ولأنّ الله يعمل فينا من خلالها وبواسطتها.

سفينة الخلاص
فلنسرع إذن إلى أحضان الكنيسة، فهي "الأم والمعلّمة" نحتمي بكنفها وتحت مظلّتها لأنّها ضمانتنا الوحيدة وملجأنا الأمين وحصننا المنيع ضدّ كلّ قوى الشرّ. فهي التي أعطت قوافل القدّيسين والشهداء، وثبتت قداستهم عبر الأجيال أدلّة ساطعة على صحة إيمانها وعقائدها. ولنصعد جميعًا على متنها فنبحر معها نحو الألفيّة الثالثة، فهي سفينة الخلاص التي تقلّنا بأمان إلى شاطئ المحبّة والسلام، إلى ملكوت الله.
لنُسرع قبل فوات الأوان، وندخل في حياة الكنيسة، مواظبين على الصلاة وعيش الأسرار لنستحقّ أن ندعى أبناءها. فهي تجسّد محبّة الله لنا وحضوره الحيّ والدائم بيننا، ولنثق بأنّ الله لم ولن يهملنا؛ ولكن نحن لم نعد نشعر بحضوره، عندما وقفت الخطيئة حاجزًا بيننا وبينه حاجبة عنّا كلّ النِّعَم وكلّ الحبّ.
ونطلب من الله أن نكون مخلصين لكنيستنا أمينين على تعاليمها، غيورين على عيش إيماننا بشكل صحيح، فنكون قدوة يُحتذى بها ورسلاً نشهد لإيماننا في العالم شهادة حقيقيّة ونقبل مشيئة الله بكلّ محبّة واستسلام كامل لإرادته ومشروعه الخلاصيّ لجميع البشر.
ولنلتمس منه بشفاعة أمّنا مريم، نعمة التوبة الصادقة ونعمة المحبّة التي هي مختصر اللاهوت كله ومفتاح باب السماء. فننعم بالسعادة الأبديّة مع الملائكة والقدّيسين. آمين.
صلاة لأجل التوبة(ص:16)
صـــلاة
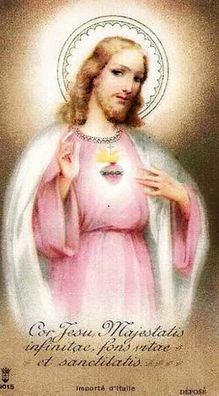
أيّها الآب السماوي، يا من بمحبّتك ورحمتك اللامتناهية للبشر، ارتضيت أن تُرسل لنا ابنك الوحيد يسوع الحبيب، ليتألّم ويموت على الصليب ذبيحة عنّا وكفّارة عن خطايا البشريّة جمعاء، فأعطي معنى لآلامنا وقوّة لضعفنا ورجاءً لحياتنا.
هبنا باستحقاقاته نعمة الإيمان الحقيقيّ، والتوبة الصادقة، فنكفر بالخطيئة بصدق وثبات، فلا نخسر حبّك وحنانك، بل نُدعى أبناءك الشاهدين لك في العالم؛ هذا الذي عمّ فيه الفساد والإلحاد، وحجب عنه نورك ورحمتك، وتجاهل حضورك الحيّ.
امنحنا يا ربّ نعمة، ان نشارك يسوع آلامه بإحتمال آلام هذا العالم فتتحوّل عندئذ آلام خلاصيّة، تكون بلسمًا لجراحاته الطاهرة، وجسر عبور إلى الحياة الأبديّة المعدّة لنا منذ إنشاء العالم، بنعمة الثالوث الأقدس وبشفاعة أمّنا العذراء وجميع القدّيسين. آمين.



































