والذين يسخرون مني فليندهشوا لخزيهم (مز 70 /4)
ميمر على الصلبوت - 1-2-3 - للأنبا بولس البوشي أسقف مصر - من مخطوطات الدير
1

+ ميمر على صلبوت ربنا يسوع المسيح للأنبا بولس البوشي أسقف مصر في القرن الثالث عشر الميلادي،
نقلاً عن المخطوطة م 18 (ورقة 83 وجه إلى 107 ظهر) - مكتبة دير القديس أنبا مقار ببرية شيهيت.
بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد
(نبتدئ بعون الله تعالى وحسن توفيقه بشرح ميمر قاله القس المكرم بولس البوشي على صلبوت ربنا يسوع المسيح وآلامه المحيية، يُقرأ بعد الساعة السادسة من نهار الجمعة الكبيرة، بركة قائله تكون معنا، آمين).
يا الذي بالصليب قهر الشيطان، أيها المسيح، خلِّصنا نحن كافة شعبك المؤمنين باسمك من تجارب العدو، بقوة لاهوتك الذي يسود الكل.
يا مَن بالصليب خزَّق كتاب خطايانا، أيها الرب القدوس، تجاوز عن سيئاتنا بتحننك الذي لا يوصف.
يا مَن بالصليب شقَّق الصخور وفتح القبور وأقام الأموات، أيها السيِّد، ليِّن قلوبنا الحجرية وأقم عقلنا الميت بكدر الخطية، لأنك تعطي الحياة الأبدية.
![]()
يا مَن بالصليب أضأت مخادع الظلمة، أضئ ظلمة قلوبنا بنور مجدك العجيب، وهَبْ لي أنا الحقير فهماً لأتكلم بسرِّ تدبيرك.
يا مَن بالضعف الذي من قِِبله غلب قوة الأقوياء، أَعطِِ قوةً لعقلي المسترخي لكي أنطق بكيفية آلامك المحيية.
هَبْ لي معرفةً يا مَن وهب الخلاص بصليبه مجاناً للذين كانوا في وثاق المسكنة مذلولين منذ بدء العالم، ثم ولكافة المسكونة أيضاً إلى الأبد وانقضاء الدهر،
لكيما أُخبر بمحبتك لجنسنا، وكيف بذلتَ ذاتك عنا حتى أحييتنا من الموت الذي كان واجباً علينا.
أنت الذي يعلو كل الآلام، من أجلنا قَبِلتَ الآلام.
الذي يُعطي الحياة لكل ذي جسد، من أجلنا قبلتَ الموت.
أنت الذي تفوق كل البرايا، من أجلنا نحن البشر تنازلتَ للصليب.
عجيبةٌ هي أعمالك يا ربُّ، وعميقةٌ جداً تدابيرك، وآثارك لا تُعرف، أيها السيِّد، وسُبلك لا تُفحص، أيها القدوس.
أنت بالصليب المقدس أظهرتَ الغلبة، وبموتك المُحيي دُسْتَ الموت المُهلك، وأبطلتَ شوكته التي هي قوة الخطية، وعتقتنا منها نحن المسجونين للموت.

خشبةٌ بغير سلاح، أعني الصليب المقدس، غَلَبَ وقهر الذين لا يُقهَرون بالسلاح، أعني الشيطان وجنوده.
جسدٌ مقدسٌ غريب من الخطية، قتل الخطية وأبادها وعتقنا من أشجابها (أي حزنها).
الخروف الذي بلا عيب سيق إلى الذبح كما تنبأ إشعياء النبي، ورُفع ذبيحةً كاملة، وبرفعهِ أكمل الذين يتقدَّسون به إلى الأبد.
فصح التمام والكمال الذي هو العهد الجديد خلَّصنا من عبودية فرعون المُرة، الذي هو الشيطان المارد إلى الأبد. وذلك أن الله لما ضرب فرعون والمصريين بالضربات المؤلمة لم يُخلي فرعون الشعب، بل قسَّى قلبه كقول الرب لموسى عَبْدَهُ:
«فقال الله لموسى: أخيراً بقيت هذه الضربة الواحدة وفيها يخلي سبيلكم وتخلصوا من عبودية فرعون إلى الأبد.
فأمُر الآن بني إسرائيل أن يشتري المرء منهم خروفاً على قدر عدد أهل بيته، ويكون خروفاً حولياً لا عيب فيه، ويُحفظ عندهم من العاشر في الهلال إلى الرابع عشر منه،
فيُذبح عند المساء، ولا يؤكل مطبوخاً بل مشوياً بالنار، وينضحوا من دمه على عتبتي الأبواب والخدين (القائمين) التي لبيوتهم،
وكلوه وأوساطكم مشدودة، وأحذيتكم في أرجلكم، وعصيكم في أيديكم، وكلوه بسرعة، لأنه فصح الرب. وما كان يؤكل منه فكلوه، وما لا يؤكل منه فاحرقوه بالنار.
ولا يُكسر له عظم. فإني في هذه الليلة أطوف مصر وأُهلك جميع أبكار المصريين، فمَن وجد علامة الدم على باب بيته فهو يخلص من الملاك الذي يهلك الأبكار(خر 12: 1-13).
فقد تقدم التفسير في الميمر الذي للشعانين، بأن الخروف هو المسيح، وأنه كاملٌ في كل زمان وأوان، وأنه وحده بلا عيب، وأنه دخل إلى أورشليم من العاشر في الهلال ومكث إلى الرابع عشر منه، الذي فيه يُذبح الفصح.
فعمل (المسيحُ) المثالَ أولاً، ثم أعطى رسله فصح التمام الذي هو جسده ودمه، فنفسِّر بقية الفصل.
وذلك لما ضرب اللهُ فرعونَ والمصريين بالتسع ضربات المؤلمة، ولم يدع فرعون الشعب، قال الله لموسى:
«بقيت هذه الضربة الواحدة، وفيها يُخلي سبيلكم».
لذلك المسيح لما صار مع البشر ليُخلِّص شعبه، ضرب الشيطانَ على نهر الأردن، وصوت الآب الصائر إليه والروح نازلاً عليه. وكما أن فرعون عندما يتألم من الضربة وتُزال عنه، يجد فسحة فيتقسَّى قلبه ولا يدع الشعب،
كذلك إذا كان فعلٌ يصنعه الرب يليق بلاهوته يقول الشيطان هذا هو المسيح مخلِّص العالم قد جاء، فيتألم جداً ويحزن كثيراً، فيصنع الرب للوقت شيئاً يليق بالبشرية لأنه إله متجسِّد، فله أن يصنع كلاهما، وهو فاعل واحد بلا انقسام.
ولما جاء صوت الآب شهد أنه ابنه الحبيب، وهبط عليه الروح، قال (الشيطان) حقاً هو المسيح الرب الابن الخاص، فحزن كثيراً.
وللوقت صعد (الربُ) إلى الجبل وصام أربعين نهاراً وأربعين ليلة ليُعلِّمنا أن نسلك في أثره. فتقدَّم إبليس ليُجرِّبه، وقال له:
«إن كنتَ أنت ابن الله، فقُل لهذه الحجارة أن تصير خبزاً»، وإنما قال له هذا لأجل ذلك الصوت الذي شهد أنه ابنه. فلم يدفع الرب له كمراده، بل انتهره وأبعده.
وكذلك فعل آياته بسلطان: مثل تطهير البُرص، وإخراجه الشياطين، وإقامته الأموات، وإشباعه الجموع من خبز يسير، ومشيه على المياه، وانتهاره الرياح، وشفاء اختلاف الأمراض، وإنهاض المخلَّعين، وفتح أعين العمي، وآذان الصم، وما سوى ذلك.
وليس هذا فقط؛ بل وزاد ذلك ظهوراً بما أعطى رسله أن يصنعوا باسمه القدوس قائلاً:
«اشفوا المرضى، أقيموا الموتى، طهِّروا البُرص،
أخرجوا الشياطين، مجاناً أخذتم مجاناً أعطوا».
هذه هي الضربات المؤلمة لإبليس وجنوده عندما يعلمون أن المسيح الذي تنبأ عنه الأنبياء قد حضر وأنه أظهر أفعالاً لائقة بربوبيته، وكيف أعطى رسله السلطان بكلمته فقط لقوم ضعفاء أن يصنعوا الآيات باسمه، لأنها لا تكون إلا باسم الإله الذي له القوة في كل شيء.
فكان الشيطان يقلق لهذا ويضطرب جداً. فحيث يراه يصوم ويصلي ويصنع أشياء تليق بالبشرية، يجد راحةً وفسحةً كمثل فرعون ذلك الزمان، ويتمادى على شره،
ولأجل عتوِّه لم يتأمله جيداً، لأنه قاسي شرير بما اخترعه لنفسه، ولأن سقطته كانت موته، وكان الرب قد أبقاه للضربة الأخيرة التي فيها عمل الفصح الحقيقي الذي كان مثالاً؛
فلما صنع الرب المثال وأعطى رسله الكمال، أعلمهم للوقت بآلامه المحيية، وأنه يبذل نفسه عنهم وعن الكافة، وليس ذلك لأجله بل لأجلنا لمغفرة خطايانا واقتناء الحياة المؤبدة.
فيا لهذا التحنُّن الكثير والمحبة المتوافرة، القائل: «ليس حب أعظم من هذا أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبائه» (يو 15: 13)، كما شهد أيضاً:
«هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل مَن يؤمن به، بل تكون له الحياة المؤبدة» (يو 3: 16).
وفي تلك الليلة التي عمل فيها الفصح أسلم ذاته للصليب، فأكمل بصلبوته كل شيء كُتب من أجله. أَمَرَ في الناموس أن يُلطِّخوا بالدم عتبتي الأبواب الفوقانية والسفلى ثم والجانبين أيضاً،
إشارة على علامة الصليب المقدس. قال: «ويؤكل الخروف مشوي بالنار»، أعني نار روح القدس الذي به قبلناه بالإيمان.
قال: «ويؤكل عند المساء»، لأن الرب مكث على الصليب إلى حين المساء.
قال: «وتكون أوساطكم مشدودة»، أعني التعبد له باجتهاد ومحبة، كما يأمرنا بمثل هذا في الإنجيل. وبطرس يقول: «شدُّوا حقوي قلوبكم وتيقظوا إلى التمام» (1بط 1: 13)، أعني ليس شد الجسد فقط، بل والقلب أيضاً.
قال: «وتكون أحذيتكم في أرجلكم»، أعني أنه يجب علينا أن نتناوله ونحن سالكين في السبيل المستقيم، عالمين وعاملين بالوصايا الإنجيلية، كما يقول الرسول:
«أنعلوا أقدامكم بعدة إنجيل السلام» (أف 6: 15). قال: «وعصيكم تكون في أيديكم»، أعني أن نكون متمسكين بعصا القوة التي أُرسلت إلينا من صهيون (مز 110: 2)، وهي علامة الملك. وإنَّا إذا أخذناه بتحفُّظ كنحو قوتنا نرث به الملكوت المؤبدة.
قال: «وتأكلوه بسرعة، لأنه فصح الرب»، أعني أن لا نكون فيه متهاونين بل مجتهدين عاملين، عالمين أنه ليس شيئاً دون (أي لا قيمة له)، بل هو فصح الرب، الذي به أفصح عن شعبه، أي خلَّصه.
قال: «وما يؤكل منه فكلوه»، أعني مطايبه.
قال: «والذي لا يؤكل أحرقوه بالنار»، أعني مثل قرونه وأظلافه وشعره وجلده، هذا يُحرق بالنار. أعني بالمطايب التي تؤكل: للخاص والعام، مثل آيات الرب وعجائبه وإظهار مجد لاهوته؛
والتي لا تؤكل: عند بعض العوام، مثل صومه وصلاته وإكماله الأشياء اللائقة بالبشرية مع آلامه المحيية، هؤلاء الذين هم القوم الخارجين عن الإيمان يُناظروننا فيها.
فأما المؤمنون (فإنهم) يحرقونها بنار روح القدس ويُزيلون شكَّها من قلوبهم، عالمين أنه إله متأنس، فأكمل النوعين معاً، وهما لفاعل واحد جميعاً.
قال: «ولا يبيت منه شيءٌ إلى الغد»، أعني بالمساء: فروغ هذا العمر الحاضر،
والغد: الدهر المستأنف، بأن لا نفرط في شيء مما أُمرنا به ولا يبقى معنا شيءٌ من الارتياب في أمره، لئلا نُطالب بذلك إذا وُجد معنا شيءٌ في ذلك الدهر العتيد بعد الوفاة.
قال: «ولا تكسروا له عظماً»، وهذا يوحنا الإنجيلي قد ذكره لما أتى الجند وكسروا ساقات اللصَّيْن اللذين صُلبا معه، قال: «فلما انتهوا إلى الرب يسوع وجدوه قد أسلم الروح، فلم يكسروا ساقيه. قائلاً: ليتم الكتاب أنه لا يُكسر له عظم» (يو 19: 31-37)، أعني بالمكتوب في هذا الموضع لأجل خروف الفصح،
لأن الإنجيلي عَلِمَ بالروح أن جميعه نبوَّة على المسيح الرب، وكتب هذه لكي يُعلِّمنا بكمال الفصل أولاً فأول. وكما قال في الناموس «تصنعوا هذا لخلاصكم من تعبُّد المصريين»،
قال الرب: «هذا عهد جديد»، أعني أني تعاهدتكم دفعةً أخرى فاصنعوه لذكري. فأبطل بهذا القول ذلك القديم الذي لم يكن به الغاية، ولا جدوى ولا منفعة، بل إنما هو مثال لهذا لا غير، وبقي محفوظاً إلى حين الكمال، كما قال الرسول: «إن الذي كان في الناموس جميعه إنما هو ظِلٌّ لِمَا هو مزمع أن يكون وليس هي الخيرات بعينها» (عب 9: 1-12).
قال الرب: «اصنعوا هكذا لذكري»، أعني فصح الخلاص نصنعه دائماً على الهيئة التي أرانا رئيس الكهنة الأعظم، وليس لتذكار نبي ولا رسول، بل للرب إله المجد، تذكاراً دائماً كما أمرنا إلى حين مجيئه.
وكما أن في عمل ذلك الفصح أهلك الربُّ أبكار المصريين، وهي الضربة الأخيرة، وكذلك في عمل هذا الفصح الذي به الغاية أهلك الربُّ مُقدِّم رؤساء الشياطين المُعاندة لجنس البشر، الذين استعبدوهم في عمل الطوب والطين، أعني الأعمال الأرضية، ولم يدعوهم أن يطلبوا ما يليق بالسموات، وهذا لما أعلن له ذاته على عود الصليب عندما صرخ قائلاً:
«يا أبتاه في يدك أضع روحي»، فأظهر له أنه ابن الله الذي تألم عنا، ثم أظهر الروح متحداً بمجد لاهوته، وعرَّفه بنفسه ها هنا، وحكم عليه بالعدل، ونزع منه قوته وسلاحه الذي كان متكلاً عليه، أعني اسمه الذي كان على الأمم ويخدمونه مثل إله، وحط عظمته وألقاه في الجحيم.
وكما أن الرب (عندما) أهلك أبكار المصريين خافوا البقية قائلين إنَّا هكذا نهلك كلنا؛
وكذلك لما أهلك الربُّ رئيس الشياطين الذي قال فيه إشعياء النبي:
«لماذا سقطت يا كوكب الصبح» (إش 14: 12)، خاف جنودها بأسرهم وافتضحوا، وعلموا أنهم مثله سيهلكون، كما شهد الرسول قائلاً:
«إنه أبطل عنا كتاب خطايانا الذي كان مضاداً لنا، وأخذه من بيننا وطبعه في صليبه. وكما فضح مدبِّري الهواء والرؤساء والمسلَّطين وأخزاهم بأقنومه علانية» (كو 2: 14-15).
وكما أمر الله موسى أن يضرب بحر سوف بالعصاة التي بيده طولاً وعرضاً مثال الصليب المقدس، فانشق البحر وعَبَرَ فيه موسى وبنو إسرائيل، وغرق فيه فرعون وجنوده، (وكان) هو كمال خلاص الشعب من عبودية فرعون؛
كذلك الرب مضى إلى الجحيم بالنفس وهي متحدة باللاهوت وعلامة الصليب أمامه، فحطَّم الأبواب النحاس، وكسَّر المتاريس الحديد،
وأخرج النفوس التي (كانت) محبوسة هناك منذ آدم، وعبَّرهم في بحر العمق ولجج الهاوية والظلمة القصوى، وداس الموت بقوة لاهوته،
ولم تُمسك نفسه في الجحيم كما هو مكتوب، ولم يُعاين جسده غياراً (فساداً) لأنه متحد باللاهوت المُحيي، ولم يفترق من الناسوت، وأَدخل النفوس إلى أرض الميعاد الحقيقي، الموضع المقدس الذي ورثته يمينه، حيث الراحة الدائمة ومسكن فردوس النعيم.
ثم غرق فرعون الذي هو الشيطان في عمق بحر النار - وهو كمال الخلاص للشعب المؤمن - وأعدَّه لجند الشيطان بعده إلى الأبد.
«وكما أن موسى رفع الحية في البرية،
كذلك ينبغي أن يُرفع ابن البشر،
لكي كل مَن يؤمن به لا يهلك، بل تجب له الحياة المؤبدة»
(يو 3: 14).
وكما أن تلك الحية النحاس لم يكن فيها سم الحيات، وكانت تشفي مَن ينظر نحوها فقط من سم الحيات المُميتة،
كذلك اتحد المسيح بجسد كامل مثلنا ما خلا الخطية، وبه قتل الخطية ونجَّانا منها إذا نظرنا إليه بعين الإيمان.
وكما أن ببسط يدي موسى هزم يوشع (يشوع) ابن نون وبنو إسرائيل العمالقة الذين يحاربونهم ويصدونهم عن الدخول إلى أرض الميعاد،
وكان موسى إذا رفع يديه تقوى بنو إسرائيل، وإذا حطَّ يديه تقوَّى العمالقة. فأعيت يدا موسى، فصنعوا له حجارة وجلس عليها، وهارون وحور دعَّما يديه، أحدهما من ها هنا والآخر من هنا،
وتقوَّت يدا موسى فاعتزَّت بالإيمان ومكثتا مبسوطتين إلى غروب الشمس، فهزم يشوعُ عماليقَ وقتل كثرتهم بحدِّ السيف، وقال الله لموسى:
«اكتب أنه هكذا يمحق الله عماليق من تحت أديم السماء»
(خر 17: 14).
وهكذا لما حارب جنسنا عماليق - الذي هو الشيطان وجنده أعداء الحق، ليصدونا عن الدخول إلى أرض الميعاد الحقيقي، أعني الملكوت المؤبدة التي وعدها الله لكافة قديسيه - أتي الربُّ لخلاصنا.
وحيث هو غير متجسِّد ولا يُرى، اتحد بجسد بشري يقبل به الآلام عنا، وهكذا رفعه على الصليب، وبسط يديه المقدستين، بقوة اللاهوت قهر الشيطان،
ومكث مبسوط اليدين إلى غروب الشمس على عود الصليب، وتم المكتوب إنه هكذا يمحق الله عماليق من تحت أديم السماء، أعني العدو المحارب لجنس البشر لئلا يدخلوا إلى أرض الراحة المؤبدة، التي وعدها الله لكافة الأبرار.
وكما كانت يدا موسى مدعومتين على اثنين، كذلك صلبوت الرب على الشعبين: بنو إسرائيل والأمم.
وكما أن موسى جلس على الحجارة وهو مبسوط اليدين إلى كمال النهار، كذلك الرب جعل اسمه على الكنيسة المقدسة المبنية على صخرة الإيمان إلى الأبد، هذه التي اشتراها بدمه الكريم بالصليب المقدس.
+ + + + + + +
2
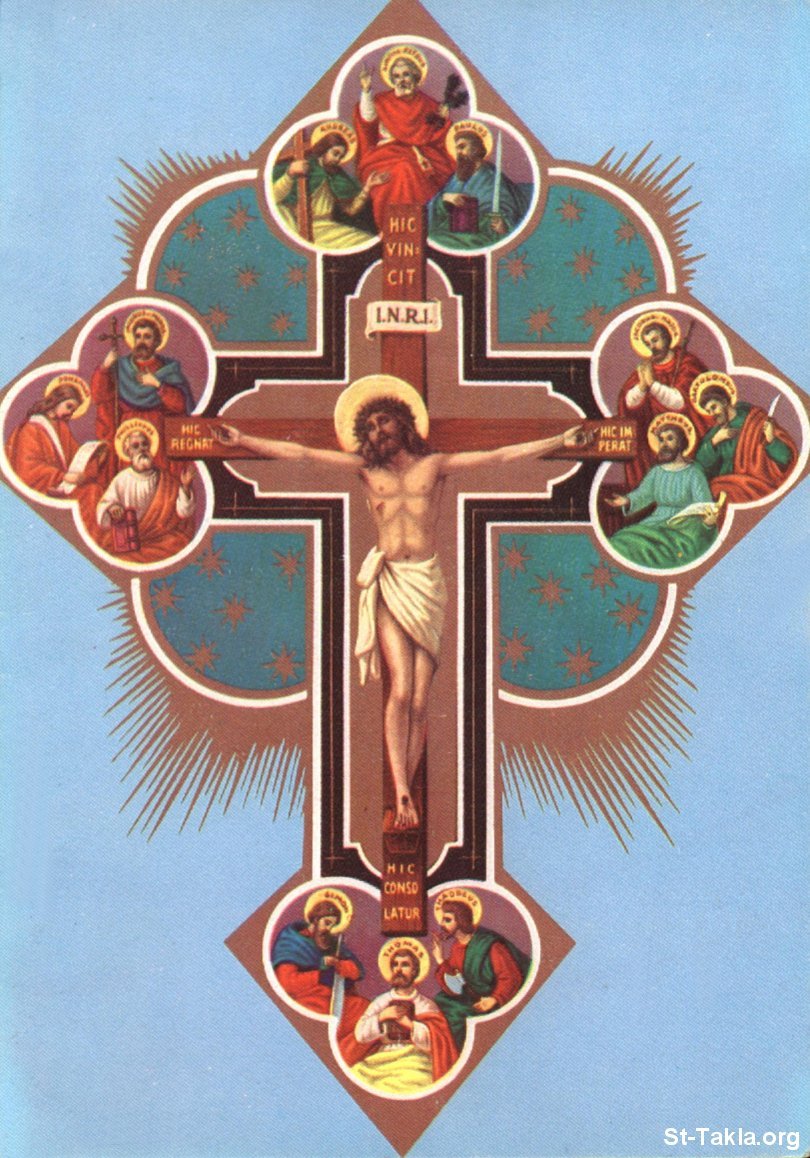
ميمر على صلبوت ربنا يسوع المسيح للأنبا بولس البوشي أسقف مصر في القرن الثالث عشر الميلادي،
نقلاً عن المخطوطة م 18 (ورقة 83 وجه إلى 107 ظهر) - مكتبة دير القديس أنبا مقار ببرية شيهيت.
هذه الأشياء وأمثالها (أي صلاة موسى وهو مبسوط اليدين على هيئة صليب) صنعها موسى وكانت نبوَّة على المسيح الرب، كما قال الرب لليهود: «ذاك كُتب من أجلي».
وشهد لتلاميذه في طريق عمواس لما بدأ يُفسِّر لهم ما في ناموس موسى والأنبياء وجميع الكتب على آلامه وقيامته، لكي نفهم نحن هذا من بعد أولئك،
ونعلم أنه بإرادته قَبِلَ هذه الآلام بأسرها، وكذلك أَذِنَ للأنبياء بالروح أن يتكلَّموا بها. كما شاء وتجسَّد، لأنه حيث هو غير منظور ولا متألم في جوهر لاهوته،
اتحد بجسد ليقبل به الآلام عنا، ولم يتحد به خلواً من النفس العقلية، بل بنفس ناطقة عاقلة، وهذه التي لها قبول الآلام ومذاقة الموت، التي أعلنها قائلاً: «إني أضع نفسي لآخذها، وليس أحدٌ يأخذها من يدي، بل لي سلطان أن أضعها، ولي سلطان أن آخذها» (يو 10: 18).
فيا للعجب، أن الذي يعلو كل فهم، غير المتألم بلاهوته، قَبِلَ الآلام بالجسد لأجلنا. (أما) الجسد فهو له بالاتحاد، فلهذا حُسبت له الآلام.
ملك الملوك وديان كل الأرض اجتمعت عليه رؤساء الشعوب بمؤامرة سوء،
ليتم المكتوب في داود القائل:
«قامت ملوك الأرض ورؤساؤها واجتمعوا جميعاً على الرب وعلى مسيحه»
(مز 2: 2).
المتكلِّم في الناموس والأنبياء والرسل، واهب النطق للبشر، كان صامتاً في الحكم، ليتم المكتوب في إشعياء القائل: «الذي تخشاه كل السلاطين ويسود كل الممالك»، من أجل تواضعه احتقره هيرودس وعبيده،
ليتم المكتوب في إشعياء القائل: «رأيناه لا منظر له ولا بهاء، لأن منظره كان حقيراً وهو متواضع كأبناء البشر، وهو ذو أوجاع وعارف بالآلام،
فرددنا وجهنا عنه ولم نعده شيئاً،
وهو الذي حمل خطايانا وصبر على آثامنا، وحسبناه مجاهداً ومضروباً،
وهو يُقبل إلى القتل من أجل خطايانا،
وصبر على آثامنا، وأدب سلامتنا عليه، وبجراحاته نبرأ» (إش 53: 2-5).
الملتحف بالنور كالرداء ألبسوه ثوباً أحمر، ليتم المكتوب في إشعياء أيضاً القائل: «مَن هو هذا الجاي من أدوم وثيابه حُمر من بوصار، بهياً هكذا في ثيابه عزيزاً بقوته».
وذلك لما سبق النبي وأبصر بالروح كيفية آلام المسيح صرخ هكذا قائلاً: «مَن هو هذا الجاي من أدوم»، لأن أدوم تُفسر على أنها السماء،
كما يقول داود: «مَن يبلغني إلى القرية العزيزة، ومَن يرشدني إلى أدوم» (مز 60: 9)، هذه التي منها جاء الرب لخلاصنا. قال: «وثيابه حُمر من بوصار» وقد فُسرت بوصار بموضع الحُكْم، هذا الذي منه خرج الرب لابساً ثياباً حمراً أرجوان.
فأجابه الرب للوقت بالروح قائلاً: «أنا المتكلِّم بالبر وبكثرة الخلاص»، أعني أنه البار وحده ولأجل خلاصنا الكثير الأنواع أتى.
فسأله النبي وهو مذهول قائلاً: «فما بال ثيابك حُمر، ولباسك كمثل من عصر بالمعصرة». أجابه الرب أيضاً قائلاً:
«أنا دُستُ ومليت ولم يكن إنسان من الأمم معي، فدستهم بغضبي ووطئتهم برجزي».
وهذا شبيه قول الرب لتلاميذه: «إنكم تتفرقون وتتركونني وحدي، ولست أنا وحدي بل الآب معي».
وقوله: «وطئتهم برجزي» ليدل أنه الحاكم المنتقم. قال: «وأنزلت دماءهم على الأرض» ، أعني بدمائهم نفوسهم التي نزلت إلى أسافل الأرض الذي هو الجحيم.
قال: «لأن يوم المجازاة أتى عليهم»، أعني الدينونة العتيدة.
قال: «وسنة الخلاص قد حضرت» ، أعني كل سنة يعملون مثال الفصح ولم يكن به الخلاص ولا الغاية، بل إنما هو مثال لما هو مزمع لا غير.
فأما هذه السنة خاصة فقد حضر فيها الخلاص بفصح الكمال الخروف الذي بلا عيب المسيح. قال: «فإذ ليس معين لي ولم يكن مَن يسندني، فخلَّصني ذراعي» (إش 63: 1-5)،
أعني أن كلهم لا شيء. فلما رأيت اتفاقهم عليَّ في الشر، خلَّصني حينئذ الذراع القوي، لاهوتي الذي لا يُقهر.
اليوم، يا أحبائي، راعي الرعاة الأعظم كمثل خروف سيق إلى الذبح، كنبوَّة إشعياء النبي. الذي يعلو كل الآلام تألم بالجسد لأجلنا لكي يُخلِّصنا من قِبَله، ويروي كل عطشان، أعطوه الخل على عود الصليب ليشرب، ليتم المكتوب في الزبور:
«أن عند عطشي سقوني خلاً» (مز 69: 21). الذي يُعطي تاجات مجد وكرامة للمجاهدين، كُلِّل بإكليل الشوك، الذي يهب البشر إكليل مجد في ملكوته الأبدية.
الذي جلَّل السماء بالغمام وزيَّن الأرض بالأزهار، اقترعوا على لباسه، ليتم المكتوب في داود القائل: «اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي اقترعوا» (مز 22: 18).
الشمس أظلمت لأجل شمس البر، ليتم المكتوب في عاموص النبي القائل:
«في ذلك اليوم، يقول الربُّ، تغيب الشمس نصف النهار وقت الظهيرة، وتظلم الأرض ونور النهار» (عا 8: 9). العناصر تغيرت لأجل رب العناصر وكل الخليقة لأنه على عود الصليب. الأرض تزلزلت وقوات السماء اضطربت. الصخور تشقَّقت، والقبور تفتحت، والأموات نهضت.
فأما رؤساء الكهنة (فقد) مكثوا على ضلالتهم، وأضلوا الشعب معهم، كالمكتوب عنهم في إشعياء النبي القائل:
«يا شعبي الذين يزعمون أنهم يحسنون إليك أضلوك، وطريق رجلك أفسدوها» (إش 3: 12). ليتم عليهم قول الرب:
«إنهم لم يدخلوا ولا تركوا الداخلين أن يدخلوا» (لو 11: 52). ولما عاينوا اضطراب وجه السماء والأرض لم يرهبوا، حتى أن الصخور لانت وقلوبهم لم تلن، ومن شدة حسدهم لم يتأملوا ذلك، بل كانوا محبين في قتله لئلا يعلو ذِكْرُهُ عليهم.
فأما اللص اليمين، وإن كان قاتولاً عاتياً، فإنه تأمل ذلك الذي كان وحقَّقه وفكَّر في نفسه قائلاً: بحق إن هذا هو المسيح الرب، ولأجله صار هذا بأسره.
فلم يتهاون ولا التفت لِمَا هو فيه من ألم الصليب والقتل، ولكنه صرخ بصوتٍ عالٍ قائلاً: «اذكرني يا رب إذا جئتَ في ملكوتك».
يا لهذا الاعتراف الحسن الذي كان لهذا اللص، هذا الذي كان أولاً متعدِّياً للوصية، ولم يَطُف معه حتى يشاهد أيامه، ولم يُعطَ سلطان الشفاء كمثل يهوذا الاسخريوطي المُسلِّم لسيده،
ولم يقرأ كتب الأنبياء كمثل أحبار اليهود؛ بل لما رأى تغيير وجه السماء والأرض فقط وهو مصلوب، صرخ قائلاً: «اذكرني يا رب إذا جئتَ في ملكوتك».
انظروا حُسن يقينه وكيف بدأ أولاً يرد اللوم على نفسه عندما انتهر رفيقه أن يسكت قائلاً: «إنَّا بحق وعدل جوزينا كما فعلنا، فأما هذا لم يصنع شيئاً من الشر». ثم صرخ إليه باعتراف حسن مملوء إيماناً قائلاً:
«اذكرني يا رب إذا جئتَ في ملكوتك».
يخزون الآن أحبار اليهود الذين يقرأون الناموس، وهم مُعلِّمون لقوم آخرين، لأنهم إنما يقرأون المداد ويُقبِّلون الورق فقط، فأما الروح الذي في الكتاب لم يفهموه.
ولأجل شرهم وخبثهم لم يكن فيهم روح الله، لأن روح الأنبياء انخضع للأنبياء كما هو مكتوب (1كو 14: 32). وبحق أنهم يشبهون شجرة التين التي لم يوجد فيها إلا الورق فقط،
شبه ورق الناموس الذي كانوا يقرأونه، ولم يوجد فيهم الثمرة التي هي العمل بالناموس، لأنه يؤول إلى المسيح. ولهذا وجب عليهم اللعنة،
ولم يعودوا يُثمرون إلى الأبد، لأنه قد بطل منهم الكهنوت والنبوَّة والمُلْك مع بقية العمل بالشريعة الأولى، لأن غايتها المسيح، وبدَّدهم في كل الأمم.
فيخزون ويُرذلون إذا سمعوا لصاً لم يقرأ الكتب لمَّا نظر ما قد حدث بغتة أظهر العمل بالشريعة من يقينه الصالح وهتف معلناً قائلاً: «اذكرني يا رب إذا جئتَ في ملكوتك».

ولأن الربَّ من أجل تحننه لم يَدَعْهم بغير إظهار عجائب في وقت الصلبوت، بل عجائب شتَّى أحدثها بغتة في السماء وعلى الأرض لكي يجذب عقولهم، فلما تمادوا على شرهم صارت الحجة عليهم.
ثم (بدأ) اللص يتأمل ذلك، ويصرخ في وسط الجمهور مُبكِّتاً لهم مُظهِراً عِظَم ربوبيته (ربوبية الرب يسوع)، قائلاً: «اذكرني يا رب إذا جئتَ في ملكوتك».
انظروا الآن إلى قوة هذه الكلمة، سأل تذكاره وليس من إنسان، بل مُقِرٌّ ومعترفٌ أنه ربُّ المجد. وفي أي وقت يذكرك، قال: عند إتيانه في استعلانه الثاني في مجد ملكوته. وبحق أنه لما شاهد هذه العلامات بتمييز صحيح، زاده الربُّ ضياءً حتى حقَّق معرفته جيداً، لأن مَن له يُعطى ويزداد.
ولم ينذر بمجيئه الأول فقط، بل والعتيد أيضاً، الذي سيكون في مجده المرهوب مع قواته المقدسة. ومن حرارة الإيمان لم يُخفِ ذلك بل صرخ: «اذكرني يا رب إذا جئتَ في ملكوتك».
فيا للعجب أن التلاميذ اختفوا، والأعلاَّء (المرضى) الذين أبرأهم الربُّ من سائر الأوجاع المختلفة لم تعترف به في ذلك الوقت، بل لصٌّ صارخٌ في وسط ذلك الجمع المحتفل،
كمثل كاروز مبشر قائلاً:
«اذكرني يا رب إذا جئتَ في ملكوتك».
وأن الربَّ ذا الرحمة والتحنُّن أعطاه أفضل مما سأل وتمنَّى، وأجابه بصوت مملوء عزاءً قائلاً:
«الحق أقول لك: إنك اليوم تكون معي في فردوسي».
فالمسيح اليوم، يا أحبائي، ميَّز ذاته كمثل خروف رُفع ذبيحة مع أجل خطايانا، كما كُتب من أجله، وهو رئيس الكهنة الأعظم رَفَعَ الذبيحة لا غيره،
كما قد سمَّاه الرسول لأجل هذا اليوم خاصة، ورفعه ذاته ذبيحة قائلاً: «إنه قرَّب نفسه مرة واحدة ليُبطل الخطية» (عب 9: 25؛26).
وهو الإله بالحقيقة الذي إليه رفع الذبيحة وقابل الطلبة وغافر الخطية، إذ تسمعه يقول للص: «الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس».
وذلك لأن الثالوث القدوس فعلٌ واحد في اللاهوت، فهو الآن الذبيحة، وهو الكاهن مُقرِّب الذبيحة عن الخطايا، وهو الإله غافر الخطايا، كما قد أخبرنا الرسول بهذه الأشياء قائلاً:
«إن المسيح قرَّب نفسه مرةً واحدةً، وبأقنومه غسل خطايا كثيرين، وسيظهر مرة ثانية للذين يرجونه بلا ذنب ولا خطية لحياة الأبد» (عب 9: 28).
فلهذا لمَّا رفع ذاته ذبيحةً على الصليب، كمثل رئيس كهنة، أظهر مع ذلك فعل اللاهوت، وقَبِلَ طلبة اللص قائلاً: «الحق أقول لك: إنك اليوم تكون معي في الفردوس». فهذه الثلاثة أكملها الرب على عود الصليب.
(فلمَّا) سأله اللص بتواضع أن يذكره في ملكوته، وهب له الدخول إلى الفردوس قبل كل أحد. فيا للعجب أن أنفس كل الأنبياء والصدِّيقين من آدم إلى مجيء المسيح (كانت) معتقلة،
وهم منتظرون هذا اليوم، وقد تحمَّلوا ثقل النهار وحرَّه بطول مكثهم، استحق هذا اللص الدخول إلى الفردوس قبلهم، وذلك لأنه كان مع السيد الملك حاضراً، قال له الرب: الحق أقول لك قولاً بتحقيق، كمثل مَن يقسم بيمين، أنك اليوم الحاضر هذا، لا بعد أزمنة كثيرة، تكون معي أنا خاصة لا غيري في فردوس النعيم.
فعندما أَسلم اللصُ الروحَ، اختطفه قوة اللاهوت الضابط الكل، الحال في كل مكان، الكائن مع كل مَن يصرخ إليه، وأدخله للوقت الفردوس.
فإن كان ملوكُ الأرض الذين هم بشرٌ مثلنا تجد أمرهم نافذاً في جميع تخوم مملكتهم، فبكم أحرى يكون (ملكُ) المملكة التي تسود الكل، وتضبط السموات والأرض وجميع ما فيها ببساطة (أي بغير محدودية) اللاهوتية، أن يفعل ما يشاء وينفذ الأمر بغير مانع، إذ الكلُّ خاضعٌ تحت سلطان ربوبيته.
طوباك أيها اللص الذي صار في ساعة واحدة باراً صدِّيقاً، لأنك بُشِّرتَ من فم الرب بدخولك الفردوس قبل أبيك آدم والذين معه منذ زمان طويل.
فليخزوا الآن الذين يدينون إخوتهم في ظاهر أمرهم لوقتهم الحاضر، لأنهم ما يعلمون آخرة ما يكون لنا ولهم، ولا كيف ملاقاة الرب بعد الوفاة،
وينظرون إلى يهوذا الذي كان معدوداً مع جملة التلاميذ وإلى اللص الذي كان محسوباً مع القاتولين (القتلة)، وكيف في ليلة واحدة ويوم واحد ابتدلا كلاهما:
يهوذا سقط من مجد التلمذة وخنق نفسه ومضى إلى الهلاك المؤبد، واللص دخل قبل كل الصديقين إلى الفردوس وظفر بحياة مؤبدة لا تنقضي.
ولما قَبِلَ ربنا يسوع، يا أحبائي، هذه الآلام بأسرها على عود الصليب من أجلنا، علم أنه قد دنا الوقت الذي فيه يُسلم الروح ويُخلِّص النفوس المحبوسة؛
سلَّم والدته القديسة الطوباوية مريم لتلميذه يوحنا الإنجيلي، لأنه خاصة كان قائماً عند صليبه دون بقية التلاميذ، لكون رئيس الكهنة يعرفه.
فمضى بها (يوحنا) إلى بيته لكي لا تُشاهده (أي الرب) عند إسلام الروح فتقلق، لأن الربَّ إلهٌ متحنِّن في كل شيء.
ثم بعد هذا كله لمَّا علم أن كلَّ شيء قد كمل، ليتم المكتوب قال: «أنا عطشان». عطش ينبوع الحياة ليروينا نحن من امتلائه الذي لا يُحدُّ،
وهو القائل: «مَن كان عطشاناً فليأتِ إليَّ ويشرب».
وقال للسامرية: «مَن يشرب من الماء الذي أنا أُعطيه لا يعطش إلى الأبد، لأن الماء الذي أنا أُعطيه فيه ماء ينبوع الحياة المؤبدة».
وإنَّ واحداً من القيام أخذ اسفنجةً ملأها وأدناها إلى فيه، فلما شرب الخل قال: «قد تمَّ الكتاب»، أعني الذي تقدَّم ذِكره القائل: «عند عطشي سقوني خلاً».
وإنما قال أنا عطشان لا لأن الخل يروي من العطش، بل ليتم المكتوب، ويظهر أيضاً مكيدة اليهود الأشرار، وأن كلما صنعوا به كان بضد الناموس الذي يزعمون أنهم به متمسكون؛ لأنه جرت العادة بأن يسقوا مَن يريدون قتله الماء، فأما هذا لما طلب الماء سقوه خلاً،
قال الكتاب: «فأمال رأسه وأسلم الروح»، أعني أنه موت اختياري لا مقهور.
فأما متَّى ومرقس فذكروا الصوت الذي ناداه بالعبراني، وهو أول المزمور الحادي والعشرين: «إلهي إلهي لماذا تركتني». قال هذا ليجذب عقول ذوي الفهم إلى بقية المزمور، لأن فيه ذكر داود آلام الرب واجتماعهم عليه، واستهزائهم به، والمسامير واقتسام ثيابه بالقرعة، قائلاً:
«أحاط بي كلابٌ كثيرة، جماعة الأشرار اكتنفتني. ثقبوا يديَّ ورجليَّ واقتسموا ثيابي بينهم، وعلى لباسي اقترعوا. وقالوا إن كان متوكِّلاً على الله فيُنجيه ويُخلِّصه إن كان يحبه».
فلهذا ذكر الربُّ أول هذا المزمور على عود الصليب، ولم يذكره بلغة أخرى سوى العبرانية التي هو بها مكتوب، لكي يفهموا إذا قرأوا.
وقد ذكر متَّى ومرقس الخل أيضاً، وأنَّ الرب صرخ بصوت عظيم وأَسلم الروح، لنعلم أنه بإرادته أسلم الروح بقوةٍ لا بضعف.
وأما لوقا فإنه بيَّن لنا ما هو الصوت، فقال: «وصرخ يسوع بصوتٍ عالٍ قائلاً: يا أبتاه في يديك أضع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح».
ومعلوم أن الذي يضعف ويخرس منطقه، فبجهد يسلم الروح، فأما هذا فإنه صرخ بصوت عظيم ليُعلن أنه ابن الله، وهو القائل:
«إني أضع نفسي لآخذها أيضاً، ولي سلطان (أن) أضعها ولي سلطان أن آخذها، وليس أحدٌ يأخذها من يدي».
وقال ها هنا: يا أبتاه في يديك (أضع) روحي، وذلك لأنه (المسيح) يدُ الآب وقوته، كما قال الرسول، وأن الثالوث القدوس فعلٌ واحد.
+ + + + + + +
3

+ ميمر على صلبوت ربنا يسوع المسيح للأنبا بولس البوشي أسقف مصر في القرن الثالث عشر الميلادي، نقلاً عن المخطوطة م 18 (ورقة 83 وجه إلى 107 ظهر) - مكتبة دير القديس أنبا مقار ببرية شيهيت.
وقد قال (المسيح) هذا («يا أبتاه في يديك أضع روحي») عند إسلامه الروح، لأن الشيطان كان مُسلَّطاً على النفوس منذ آدم لأجل المخالفة، فلما جاء الربُّ من السماء، الذي تجسَّد وصار آدمَ ثانياً لرجاء الحياة المستأنفة، قال: «يا أبتاه» ليُعلن أنه ابن الله الوحيد.
قال: «في يديك» الذي هو واحد معه في اللاهوت. قال: «أضع روحي»، أعني كما أن بآدم تسلَّط الشيطان على الأرواح، كذلك فيَّ أنا من الآن يخلصون ويكونون في يديك، يا ذا القوة.
والرسول يقول: «كما ماتوا بآدم، كذلك بالمسيح يَحْيَوْن».
قال الإنجيل المقدس عند إعلان الصوت: «للوقت انشقَّ سترُ حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل»، أعني أنه نزع منه فعل الروح القدس الذي كان فاعلاً في الناموس العتيق،
لأن غايته إلى مجيء المسيح، لكي من ذي قبل يحلّ على المؤمنين به، كما شهد الإنجيل قائلاً: «إن الروح لم يكن حلَّ بعد من أجل أن يسوع لم يكن مُجِّدَ»، أعني مجد الصليب. فلما نزع الروح من الهيكل الذي لليهود، شقَّ ستر الحجاب للوقت، لأن ضحايا الحيوان ودم الجداء قد بَطُلت برفعه ذبيحة عن الكافة وإكماله الغاية.
قال: «والأرض تزلزلت، والقبور تفتحت، وكثيرٌ من أجسام القديسين الرقود قاموا من قبورهم، وخرجوا من بعد قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة، وظهروا لكثيرين»، فخلص الشبه بشبهه، النفسُ مضت إلى الجحيم متحدةً باللاهوت خلَّصت النفوس، والجسد على الصليب متحداً باللاهوت أقام الأجساد.
وأما الزلزلة ليُعلن قوَّته، وأن موته لم يكن بضعف على غالب الموت، الذي موته زلزل الأرض بإعلان قوة الصوت، وأن موته بإرادته ومشيئته، القائل:
«لي سلطان (أن) أضع نفسي ولي سلطان (أن) آخذها».
وأما تشقيق الصخور لتبكيت الذين قلوبهم لحمية كما يزعمون، وكيف (أن) الصخور الصلبة تشققت وهم الذين يقرأون الناموس لم تلن قلوبهم ولم تخشع فيتوبوا ليغفر لهم بكثرة تحنُّنه.
قال الإنجيل: «وأما قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع لما نظروا الزلزلة وما كان، خافوا جداً، وقالوا: حقّاً إن هذا هو ابن الله»،
أعني الأمم الذين لم يكن لهم ناموس، (أي) القائد والجند الذين معه، لما نظروا الآيات الكائنة مع الزلزلة التي حدثت عند إسلام (المسيح) الروح،
خافوا جداً وخشعت قلوبهم، وبفعل المصنوعات استدلوا على الصانع، وقالوا: «حقاً إن هذا هو ابن الله».
وذلك أنهم لم يقرأوا كتاباً، بل سمعوا من اليهود لما شكوه لبيلاطس قائلين: «إنه قال عن نفسه إنه ابن الله». فلذلك قالوا عند نظرهم ما كان: حقّاً يقيناً قوله حق، وهو ابن الله بالحقيقة بلا شك ولا امتراء (مراءاة).
قال الكتاب العزيز: «وكل الجمع الذين كانوا مجتمعين لهذا المنظر لمَّا عاينوا ما كان رجعوا وهم يدقون على صدورهم»، أعني عندما شاهدوا الآيات الحاضرة لم يتمالكوا القيام، بل رجعوا وهم متأسفون على ما فعله رؤساء الكهنة الأشرار، وكانوا يضربون صدورهم من كثرة الحزن والآلام.
فلما كملت هذه الأشياء المخوفة بأسرها، حينئذ أَذِنَ الرب أن تعود الشمس إلى ضوئها عند غروبها بعد تسع ساعات من النهار، وسكنت الأشياء واستقرت، ليُعلن أنه راضٍٍ على الأرض ومَن عليها، وأن صلبوته للرحمة لا للانتقام والغضب.
وإنما صنع هذه العلامات لتتبيَّن قوته. وأعاد ضوء الشمس ليتم المكتوب في زكريا النبي القائل: «إنه سيكون يوم واحد، وذلك اليوم معروف للرب لا نهار ولا ليل، ثم يكون الضوء أوان العشاء» (زك 14: 7).
انظروا الآن إلى قول النبي أنه يكون يوم واحد، أعني أن ليس له ثانٍ، كما قال الرسول «إنه قرَّب نفسه مرة واحدة». قال النبي:«وذلك اليوم معروف للرب»، أعني أنه له خاص معروف إلى الأبد لتذكار آلامه.
قال: «لا نهار ولا ليل»، أعني أنه مقسوم وفيه نور النهار وظلمة الليل. ثم قال: «ويكون الضوء أوان العشاء»، أوضح في النبوة بيان أن ضوء الشمس يكون قريباً من العشاء، كما قد كان.
ثم بعد ذلك مضى اليهود والذين لم تتخشع قلوبهم إلى بيلاطس وسألوه كسر ساقات المصلوبين لكي يموتوا سريعاً وينزلوهم لأجل ليلة السبت، لأن ذلك السبت كان عندهم عظيماً. لأنه سبت أيام الفطير السبعة.
قال الكتاب المقدس: «فجاءوا الجند»، أعني المُرسلين معهم من عند بيلاطس، غير الجند الأوَّلين الذين آمنوا. قال: «وكسروا ساقات اللصَّين اللذين صُلبا معه». فلما انتهوا إلى الذي يعلم الأشياء كلها قبل وقتها، وجدوه قد أسلم الروح بإرادته، فلم يكسروا ساقيه،
ليتم الكتاب: «أنه لا يُكسر له عظم»، أعني القول الذي تقدَّم عن خروف الفصح الذي هو مثال الحق المسيح.
ولكن واحداً من أولئك الجند الأشرار الذين أتوا معهم أراد الحظوة عندهم، (لذا) طعنه في جنبه بحربة، لكي يتم المكتوب في زكريا النبي القائل:
«سينظرون إليَّ الذين طعنوا» (زك 12: 10). وللوقت خرج ماءٌ ودمٌ: أما الماء يدلُّ أنه مات بحق بإسلامه النفس؛ وأما الدم ليدلَّ أيضاً أنه حيٌّ بحق باتحاد اللاهوت بجسده المُحيي بغير افتراق، لأن كلاًّ منهما كان فرادى، أعني: الماء والدم، من غير اختلاط.
داود النبي يُعلن لنا هذا الموضوع جيداً في المزمور الثامن والستين قائلاً: «جعلوا في طعامي مرارة»، أعني الخمر المخلوط بمرٍّ الذي أعطوه وقت أن أرادوا صلبه، فذاق ولم يشأ أن يشرب.
كما شهد الإنجيل فقال: «وعند عطشي سقوني خلاًّ». إن فعلهم كان تشفِّياً ببغضة خارجاً عن ناموس الشريعة وعن ناموس الملوك أيضاً، الذي جرت به العادة.
ولكن ما الذي قاله بعد ذلك؟ قال: «فلتكن مائدتهم أمامهم فخّاً ونصباً ومجازاة وعثرة» (مز 69: 22)، أعني بمائدتهم خدمتهم التي هي ضحايا الحيوان التي كانت مثالاً على جسد الرب الكريم ودمه الزكي؛ وأنه بدمه خاصة يُطهِّر الكافة.
فحيث جاء الحق فلم يقبلوه، صار ذلك الذي لا جدوى له فخّاً وعثرة بلا شك عنده. تمسَّكوا بالظل وتركوا الحق.
وقال: «وتُظلم عيونهم فلا يبصرون»، أعني أنها تُظلم عن معرفة نور الحق الآتي إلى العالم. كما شبههم الرب بعميان قادة عميان.
وقال لهم أيضاً: «إن النور معكم زمناً يسيراً، فآمنوا بالنور لئلا يُدرككم الظلمة». وقال: «وتكون ظهورهم منحنية»، أعني تحت نير الملوك الغريبة منهم، الذين قد ملكوا عليهم.
قال: «في كل حين»، (وليس في حين) واحد مثل سبي بابل، لكن دائماً في كل حين بغير تعاهُد.
قال: «صُبَّ عليهم رجزك، وتُدركهم شدة سخطك»، أعني سبي اسباسيانوس لهم مع القتل الشديد الذي نالهم منه. هذا الذي أدركهم سريعاً بعد صعود الرب بأربعين سنة.
قال: «منازلهم تكون خراباً»، أعني أنها تخرب منهم بإبادتهم بالسيف مع الجلاء والتبدُّد الذي أصاب البقية، كما قد تشاهد الآن. قال: «ولا يسكن مساكنهم مَن يعمرها»، أعني لا يعمرها على رأيهم الفاسد، بل خدمتهم تبطل منها كما قد كان ولا شيء.
قال: «لأنهم اضطهدوا الذي ابتليتَ»، أعني أنه أتى متواضعاً وقَبِلَ عليه الأشياء الواجبة علينا لينقذنا منها، كما قال الرسول:
«بما أنه ابتُلي وتألم، هو قادر على أن يُعين الذين يحزنون ويبتلون» (عب 2: 18)، فأما هم عِوَضاً من قبوله اضطهدوه.
قال: «وزادوا الجريح جراحاً»، أعني طعنه بالحربة التي زادوها بعد دق المسامير، لأن هذا الآخر بغير حكومة (أي شريعة) الملوك ولا عدل العامة، لأن الطعنة كانت بعد إسلام الروح، وكان هذا عبثاً منهم وبغضاً.
فلأجل هذا ذكر داود النبي هذين الفعلين خاصة في هذا الموضع، الخل والطعنة، ودعا أولاً عليهم بهلاك في الدنيا عاجلاً، كما قد حصل بهم، ثم ها هنا بعد ذلك دعا عليهم بالهلاك المؤبد دائماً،
فقال: «زدهم على إثمهم آثاماً»، أعني الإثم الذي صنعوه بالأنبياء يزدادون آثاماً، أضعاف ذلك لِمَا قد صنعوه برب الأنبياء.
كما قال الرب: «إن هذا كله يأتي على هذا الجيل ويُنتقم منهم، عن دم كل الصدِّيقين الذي أُهرق على الأرض، من دم هابيل إلى دم زكريا»، وذلك لأنهم تُركوا إلى مجيء المسيح.
قال: «ولا يدخلون في عدلك»، أعني بعدله المساواة بين الكل في الإيمان، لا يستحقون ذ لك لأنهم لم يطيعوا.
قال: «يُمْحَوْن من سفر الحياة»، أعني سفر الحياة الذي ذكره موسى والأنبياء، يُمْحَوْن هم منه. قال: «ولا يُكتبون مع أبرارك»، أعني (بأبرارك) الذين يتبرَّرون بالنعمة مجانـاً بـربنا يسوع المسيح، لا يكون لهم (أي لغير المؤمنين) حظٌّ في ذلك ولا نصيب لكفرهم وعتوِّهم.
هذه النبوَّات وأمثالها، يا أحبائي، أكملها الرب على عود الصليب المقدس من أجلنا، ليُوصِّل إلينا الحياة اللائقة به، سُرَّ غير المتألم أن يتألم بالجسد من أجلنا ليُوصِّل إلينا الصحة من الآلام.
سُرَّ الذي يعلو ويفوق كل مجد وكرامة أن يُرذل عنَّا ليوصِّل إلينا المجد اللائق.
سُرَّ رئيس الحياة أن يكون بالجسد من أجلنا ليوصِّل إلينا الحياة الملائمة لعظمة أزليته.
لك أيها المسيح الذي تألم عنا نعبد، ولآلامك وصلبوتك نسجد، نمجِّد آلامك ونعظِّم صليبك المقدس، ونعترف بموتك ونبشر بقيامتك، ونترجى إتيانك إلى حين مجيئك،
لأن بهذا صار لنا براً وتطهيراً وخلاصاً وافتخاراً، ونرتل مع الرسول القائل:«أما أنا فلا فخر لي إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي الدنيا لي مصطلبة وأنا مصطلب للدنيا»(غل 6: 14).
هذا الذي به أيضاً افتخرت الملائكة المقدَّسون قائلين للنسوة: «أنتن تطلبن يسوع المصلوب، ليس هو ها هنا، لكن قد قام كما قال لكم، وهذا الموضع الذي كان فيه الرب». فاعترفوا بالمصلوب أنه ربُّ المجد ولم يأنفوا، افتخروا وسُروا وبشَّروا النسوة بذلك.
فيجب علينا أن نعطي مجداً وكرامة للرب الذي شاء أن يتألم عنا من غير أن يظهر منا عملٌ صالح نستحق به ذلك، كما كرز الرسول قائلاً:
«إن كان المسيح من أجل ضعفنا مات في هذا الزمان بدل الفجار، وبالكاد ما يبذل الإنسان نفسه بدل الأشرار، فأما الأخيار عسى يجترئ الإنسان على الموت دونهم. فمن ها هنا عرَّفنا الله محبته لنا، إذ كنا خطاة أثمة مات المسيح دوننا» (رو 5: 8).
وقال أيضاً: «أنتم الذين كنتم من قبل غرباء بضمائركم وأعداء بسوء أعمالكم، ألَّف بينكم ببذله جسده للموت، ليُقيمكم بين يديه أطهاراً بلا عيب» (كو 1: 21،22).
فلا تنسى الآن آلامه المُحيية، كما أوصانا أن نتذكَّرها في كل وقت عند تقدمة الأسرار المقدسة إلى حين مجيئه في مجد ملكوته،
ونرتل قائلين: لك أيها المسيح الرب نعبد، ولآلامك المحيية ولصلبوتك نسجد. ننظر إليه بعين الإيمان ونحيا من السم الذي للحية المعقولة، هذه التي أضلَّت أبانا آدم وأخرجته من الفرودس، ولم يشفه هو وذريته إلا رفع الرب على الصليب، هو باقٍ إلى الأبد، يُعطي الحياة لكل مَن ينظر إليه بعين الإيمان، وليس لحياة زمنية، بل لحياة أبدية كما يليق به؛
إذ الرسول يأمرنا بذلك قائلاً: «نسعى الآن بالصبر في الجهاد المنصوب لنا، وننظر إلى يسوع الذي صار رئيس إيماننا ومُكمِّله، إذ احتمل الصليب بدل (أي مقابل) ما كان أمامه من الفرح».
ثم أكد قائلاً: «فكِّروا في أنفسكم كم احتمل من الخطاة» (عب 12: 1-3)، أولئك الذين صاروا أضداد أنفسهم، فأمرنا أن نجعل آلام المسيح في فكرنا، مكتوباً على قلوبنا، مرسوماً على أيدينا، مصوَّراً أمام أعيننا، ممثلاً قدامنا، وبقوة الصليب ننجو من الحيات العقلية، لأن بالصليب خَلُصَ الأبرار الذين كانوا والذين يكونون أيضاً.
بالصليب كان خلاص الآباء الأولين والأنبياء وكافة الصدِّيقين. بالصليب سبى الرب الجحيم وفتح الفردوس. بالصليب تتقدَّس الكنائس.
بالصليب يكون هبوط الروح القدس على المعمودية، وتلدنا بنين لإرث الحياة الأبدية. بالصليب يكمل تقديس الأسرار الروحانية. بالصليب يكون رتبة الكهنوت. بالصليب يكمل خدمة جميع البيعة الرسولية.
بالصليب صنع الرسل الآيات. بالصليب عمل القديسون العجائب. بالصليب اضطهد المجاهدون الأرواح الشريرة. بالصليب يتقدَّس كلُّ شيء، لأنه علامة الملك المسيح.
وحيث يُرشم في التقديسات يحلُّ الروح ويكمل القداسة، لأن الصليب علامة الابن، والروح فاعل مع ذلك. الصليب ضياء الكنيسة، ومثال فوق الهياكل.
بالصليب افتخر الملوك الأبرار. بالصليب افتخر قسطنطين وأُمه هيلانه وأولاده قسطه وقسطنس. بعلامة الصليب هزم قسطنطين جيوش البربر وظهر الصليب في أيامه وصار له بذلك ذِكْرٌ مؤبد، وصنع علامة الصليب فوق رأسه على تاجه ليكون له معونة وقوة وخلاصاً، وأباد فضلة عبادة الأوثان بقوة الصليب المقدس، ومنه صنع كل الملوك المؤمنين الصليب فوق التيجان على رؤوسهم مفتخرين بذلك، يُظْهِرون به بهاء مجد الإيمان بالمسيح الملك الحقيقي.
فنرسم نحن علامة الصليب المعظم على وجوهنا، ونحصِّن به كل أجسادنا، إذ نصنع رسمه على كل أعضائنا.
هذا المثال المقدس الذي ظهر أولاً برمز النبوَّة عند قول الله لموسى: هذه العصا التي تحوَّلت في يدك ثعباناً اصنع بها العجائب بمصر، واضرب بها البحر الأحمر طولاً وعرضاً مثال الصليب فينشق. وهذا كان مثالاً على خشبة الصليب المقدس الذي يصنع العجائب والقوات والتقديسات، وليس في زمان واحد مثل ما صنع موسى، بل في كل مكان وزمان.
هذا الذي أظهر مثاله أيضاً يعقوب إسرائيل لمَّا بارك على أولاد يوسف حين حضرته الوفاة، عندما خالف يديه كمثال الصليب وباركهم، ثم سجد على رأس عصاه.
أظهر مثال الصليب الذي به تكون البركات، وسجوده على رأس خشبة إشارة لخشبة الصليب، وكما وضع يده اليمين على رأس أفرام (أفرايم) وهو الأصغر، ويده اليُسرى على رأس منسا (منسَّى) وهو الأكبر،
وقال: إن أفرام يُعظَّم أكثر من منسا (تك 48: 18-20)، كذلك شعوب الأمم عظموا أكثر من بني إسرائيل؛ لأن صلبوت الرب على الأمم وبني إسرائيل معاً.
فيجب أن نعلم كرامة الصليب المقدس ونحفظها بكل وقار، كما أوصانا الرب أن نحمل الصليب ونتبعه لكي نستحقه، أعني أن نموت عن أوجاع العالم،
كما قد قال الرسول: «إن حياة الأحياء ليست لأنفسهم بل الذي مات عنهم وقام لكي يكون رب الأحياء والأموات» (1بط 4: 1-2).
فلتكن سيرتنا كما يُلائم موت الرب، لأن الذي قد مات قد نجا من الخطية وتحرر منها، كما يقول الرسول. ثم يعلِّمنا ما هو الموت قائلاً:
«أميتوا أعضاءكم التي على الأرض التي هي النجاسة والزنا والشهوة الخبيثة والغشم وما أشبه ذلك» (كو 3: 5).
ثم يعظنا قائلاً: «إنَّا نحتمل في كل حين في أجسادنا موت يسوع لتظهر حياة يسوع أجسادنا، فإذا كنا نحن الأحياء نُسلَّم إلى الموت من أجل يسوع، كذلك حياة يسوع تظهر في أجسادنا المائتة» (2كو 4: 10).
فقد صح أن التشبُّه بموت الرب أن نموت عن الخطية والشهوة العالمية، كما يُبيِّن ذلك أيضاً قائلاً: «إنكم لم تبلغوا حدَّ الدم في مجاهدة الخطية» (عب 12: 4).
ويأمرنا أن نخرج عن سيرة هذا العالم لنكون وارثين الدهر المستأنف قائلاً: «أما الحيوانات التي كان رئيس الكهنة يدخل بدمائها بيت المقدس عن الخطايا، إنما كانت لحومها تُحرق بالنار خارجاً عن المحلة، كذلك يسوع أيضاً لما أراد أن يُطهِّر شعبه بدمه، تألم خارجا من المدينة، فنخرج نحن أيضاً إليه خارجاً من المعسكر حاملين لعاره، لأنه ليس لنا ها هنا مدينة تبقى، بل إنما نرجو الملكوت المزمعة» (عب 13: 11-13).
أَنظرتَ الآن المماثلة في العتيقة كيف أكملها الرب حتى إلى غاية التطهير بدمه الكريم،
ولم يوجب علينا المماثلة بسفك دم لأجل ضعف البشرية، بل أمرنا بالخروج عن سيرة العالم حاملين علامة الصليب الذي يُعيِّروننا به القوم غير المؤمنين، وهو لنا مجد وخلاص.
ويُعلِّمنا أن هذا العالم لن نبقَى فيه مُخلَّدين، فلذلك يجب أن يكون رجاؤنا في تلك الملكوت المزمعة التي لا زوال لها.
نحب إخوتنا من أجل الذي أحبنا وبذل ذاته عنا. نرحم المساكين من أجل الذي رحم المأسورين والضالين ومات عن الجميع.
نصنع صُلحاً وسلاماً مع إخوتنا من أجل الذي بدم صليبه أصلح ذات كل بعيد وجعل الفريقين واحداً. نحفظ أجسادنا طاهرة وكل حواسنا لكي نموت مع المسيح عن أركان هذا العالم.
نفتقد المحبوسين من أجل الذي أخرج المعتقلين مـن لَدُن آدم وأدخلهم إلى الفردوس. هـذا هـو السلوك في إثره والمثابرة على حفظ وصاياه.
ونحن نسأل الذي اتضع بين المنافقين من أجلنا، وتألم لراحتنا، ومات لحياتنا، أن يحرسنا أجمعين، ويتحنَّن علينا مجاناً بسعة رحمته مع الذين تعاهدهم للخلاص بصليبه المقدس،
ويُلهمنا العمل بوصاياه، ويرزقنا راحة ومغفرة في حُكْمه المرهوب، بشفاعة سيدتنا الطوبانية الطاهرة البتول مرتمريم الزكية، والرسل والشهداء والقديسين الأبرار، وكل مَن أرضى الرب بأعمالهم الصالحة من الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين وإلى آباد الدهور كلها. آمين.
(تم وكمل ميمر الصلبوت بعون من الله تعالى والسُّبح له دائماً أبدياً. آمين).



































