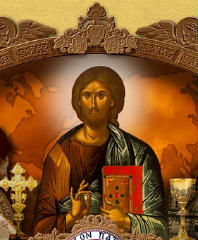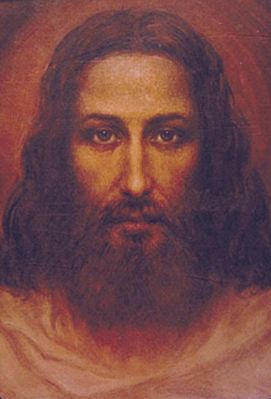أما أنتم، فطوبى لعيونكم لأنها تبصر، و لآذانكم لأنها تسمع ( مت 13 /16)
حتى لا نطلب معرفة ما لا ينفع لنكون معروفين عنده - الأرشمندريت توما بيطار
حتى لا نطلب معرفة ما لا ينفع
لنكون معروفين عنده
في حياتنا في المسيح ثمّة ما هو معطى لنا وما هو مُمسَكٌ عنا، ما هو مكشوف لأبصارنا وما هو موارًى. وما كشفه الله وما حجبه إنّما هو لخيرنا سواء بسواء.
فمن المعرفة ما نفع ومنها ما أخلَّ بالإنسان ومنها ما قتله. والقياس "أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته" (يو 17: 3). لا قيمة لشيء، في ذاته، في هذا الدهر. القيمة في ارتباطه بما هناك. "الكل به وله" (1 كو 1: 16).
على هذا، مثلاً، لا يكشف لنا الربّ الإله، في العادة، ساعة موتنا. فقط بعضنا، بحكمة منه، ليكون له استعداد أوفى لساعة المفارقة وليس قبل النجاز بكثير.
وكذا بعض مَن بلغوا قامة روحيّة مرموقة لتكون لهم تلك الساعة نذيراً نصب أعينهم كل حياتهم. في ما عدا ذلك تبقى الساعة مطويّة لا ندري من أمرها شيئاً. ولا قياس. ثمّة مَن يكونون من الموت على قاب قوسين وأدنى، عَطَباً، فلا ينحدرون إلى الجبّ ويعمِّرون. وثمّة مَن نأوا عن الشدائد ففاجأتهم وأصابت منهم المقتل ووارتهم الثرى.
لذا تلك الساعة واردة، في الإمكان، بعد لحظة، وواردة، في آن، بعد سنين أنّى تكن تدابير الناس لدرئها.
هذا، في حكمة الله، ليبقى الإنسان في أزمة وجود، في قلق كياني، في توتّر، في بحث، في انشداد إلى مَن في يده، وحده، سلامنا. "سلامي أُعطيكم لا كما يعطيكم العالم".
وهذا أيضاً حتى لا يتثقَّل أحد بهموم هذه الحياة إذ "ليست لنا ههنا مدينة باقية بل نطلب الآتية". فقط إيّاه يُرجى أن تَلتمسَ النفسُ، مَن بيده نسمتنا. "أقوم وأطوف في الأسواق وفي الشوارع أطلب مَن تحبّه نفسي"
(نش 3: 2).
الربّ أخفى خبر ساعة الموت عن الأكثرين، إذاً، حتى يتوبوا، حتى يكون لهم إلى ربّهم معاد. والتوبة سعي دؤوب متواتر إليه، حين يكون كل الإنسان مشدوداً، أبداً، إلى فوق. "وجهك يا ربّ أنا ألتمس".
ثمّة قوم لو دروا بساعة موتهم سلفاً لاستبدّ بهم اليأس لأنّهم أوهى من أن يواجهوا حقائق الوجود. يَنشأون كالطحالب. ولو درى آخرون لجنحوا إلى الكسل والتواني ممنّين النفس بتوبة صدوق متى حضرتهم الساعة، وما يقدرون لأنّ النفس إن ألفت الغربة عن الله اليوم مالت عن التوبة إليه غداً. الحسّ فيها يموت.
إن تُسْلِمِ النفسُ ذاتَها للخطيئة تكراراً تَهِنْ وتصغر وتؤثر الموت على تعب التوبة. الخطيئة قادرة أن تقتل في الخاطئ التوتّر إلى الحياة الأبدية.
كذلك لا أحد على دراية حقّانية بقامته الروحيّة. لا يعرف مبلغ ما أدركه من النضج الروحي. يُخفي الله عن عيوننا مقدار ما نمونا في مراقي الحياة الروحيّة حتى لا يتعرّض أحد للاستكبار.
ما حصّله امرئ في دهر من الجهاد يضيعه في لحظة من الاستكبار. حتى الأخير، حتى ساعة الموت، يبقى الإنسان في خطر السقوط. ومن الناس مَن إذا دروا بحالهم يئسوا.
لذلك قصير القامة يعرف الله مؤدِّباً، لكنّه يعرفه بالأكثر رحيماً. والله سمّاح بذلك رأفة به حتى تقوى نفسه على التوبة. أما مديد القامة فيألف ربّه رحيماً، لكنّه عنده، بالأكثر، صارم صارم حتى تبقى نفسُه ساهرة يقظة ولا تركن إلى كلّ شبه خطيئة.
قصير القامة يتعلّم أن يكبر صُعُداً ومديد القامة نُزُلاً. الأول متى سلك في الوصيّة كبُر في عين نفسه من جهة الله والأخير متى حفظ الأمانة صَغُرت نفسه في عينيه واعتبر ذاته حقيراً صغيراً.
عظمت خطاياه في حسّه وحسب ذاته غير أهل للخلاص من جهة نفسه إلاّ بنعمة مجّانية من فوق ولا فضل له ولا أجر لأنّه يعرف، بالخبرة، أنّه لا صالح إلاّ الله. يوم يصل البار إلى هناك تتحقّق فيها القولة الإلهية: "بالنعمة أنتم مخلَّصون بالإيمان وذلك ليس منكم. هو عطيّة الله"
(أف 2: 8).
والربّ الإله، أيضاً وأيضاً، لا يكشف لنا ما لا نفع لنا منه. لا يكشف لنا ما ستكون عليه حالنا بعد الموت. هذا إلاّ قلّة يعرفها الله ويناسبها أن تعرف إمّا لأنّ الربّ الإله يشاء أن يطلقها في مراقي التوبة والجهاد الكبير فيؤتيها رؤى تأسرها فتخرجها من ترّهات هذا الدهر وتلكّؤ النفس. "كفاكم قعود في هذا الجبل. تحوّلوا وارتحلوا... ادخلوا وتملّكوا الأرض..." (تث 1: 6 ? 7، 8).
إمّا لهذا السبب يكشف الربّ للأعزّة حالهم بعد الموت وإمّا ليزيدهم غيرة على غيرة وتوقّداً على توقّد وتعزية بعد ضنك فيتشدّدوا ويتوثّبوا ويناطحوا كل تجربة إلى حدود البَشَرة وأبعد بنعمة الله.
أمّا للسواد الأعظم فلا يناسب أن يتكهّنوا في شأن ما بعد الموت لأنّ الله لم يكشفه لهم إلاّ نُتَفاً وعَرَضاً. لذلك ليست لنا في الأرثوذكسية عقيدة بشأن ما بعد الموت.
فقط بعض رؤى وخبرات واجتهادات. لا يقين لنا، في التفاصيل، من هذه الجهة. فقط لنا يقين من جهة الوصيّة. هذه تبسّط فيها السيّد ورسله لأنّ فيها نفعاً لنا. لذلك الإمعان في التكهّن في أمور لم يُبِنْها الله ضرب من الفضولية يؤذي ولا ينفع، يُغرق في الوهم ويُبعد عن الواقعية. يكفينا أن نعرف أننا إن سلكنا في إثْر المعلّم هنا سنكون معه هناك لأنّه قال:
"أنا أمضي لأعدّ لكم مكاناً. وإن مضيت وأعددت لكم مكاناً آتي أيضاً وآخذكم إليّ حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً" (يو 14: 2 ? 3).
السؤال الذي نطرحه ينبغي، أولاً، أن يكون مناسباً لنتلقّى في شأنه جواباً مناسباً. الله لا يجيب عن كل سؤال وكأنّه آلة إجابات. لما سأل واحدٌ الربّ يسوع، من باب الفضولية، "أقليل هم الذين يخلصون" (لو 13: 23)
لم يُجبه عن سؤاله بل عن سؤال آخر كان ينبغي عليه أن يطرحه. "اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيِّق" (لو 13: 24).
والقول أيضاً صحيح من جهة معرفة علوم هذا الدهر. يكفينا أن نعرف منها قدْراً ينفعنا لنخلُص إلى "أن السموات تُحدّث بمجد الله والفلك يخبّر بأعمال يديه" ويحملُنا على الدهش أنْ "ما أعظم أعمالك يا ربّ كلّها بحكمة صنعت". فيما عدا ذلك الشغف بعلوم هذا الدهر أدنى إلى الوباء ويحمل بذار التمرّد على الله.
فيه الكثير من الغرور. وهو أدنى إلى الملهاة لأنّه يبدّد قوى الإنسان على ما لا ينفع ويحشو نفسَه بما لا طائل تحته فتهنُ النفس ولا تعود مطرحاً مناسباً لسكنى الله. تُصاب بسُكْر الأباطيل. العلوم الدنيا، في الوجدان، مرشّحة أبداً لأن تستحيل أصناماً نقدّم على مذابحها دماءنا. ثمّة استقامة في النفس من جهة حاجتنا إلى علوم هذا الدهر إذا ما اعوجّت أو اختلّت سقطنا في الشطط والتخمة. والتخمة في الفكر، إن اشتملتنا، أعتمتنا نفساً وجسداً وألقتنا في الظلمة البرّانية بأيدينا.
يبقى أنّ المعرفة التي ننشد هي أن نعرف أنّنا لا نعرف كما نحن بحاجة لأن نعرف، أن نعرف أنّنا لن نعرف إلاّ إذا أحببنا. إذ ذاك نعرف أنّ
"العلم ينفخ والمحبّة تبني. فإن كان أحد يظنّ أنّه يعرف شيئاً فإنه لم يعرف شيئاً بعد كما يجب أن يعرف. ولكن إن كان أحد يحبّ الله فهذا معروف عنده" (1 كو 8: 1 ? 3).
هذا هو الأهمّ لا بل الحاجة الوحيدة التي ينبغي أن نكون إليها: أن نكون معروفين عنده!