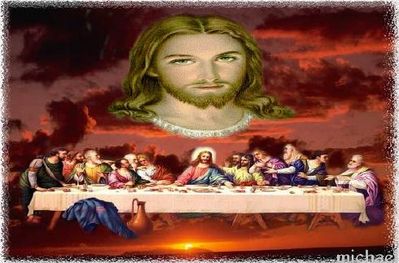فإِنِّي مَنَحتُكم عِلمًا صالِحًا: فلا تُهمِلوا تَعْليمي (ام 4 /2)
الصوم - الأرشمندريت توما بيطار
الصوم
هناك إمساك عن الطعام وعن أنواع منه وفقاً لترتيب درجت عليه الكنيسة. هذا يقترن بنظام صلوات خاصة بالفترة. أساس الصوم والصلاة التوبة.
والتوبة عودة إلى الله. الله حيّ. ولكنْ كثيراً ما لا نعرفه كذلك. نحن بحاجة لأن نتحسّس مواطن الحياة فيه. الله ليس فكرة ولا فرائض ولا شكليات. الله حضور. يسوع معنا وفيما بيننا. لذلك نصلّي لأن في الصلاة استدعاء لله. الصلاة صلة بالله. من هنا حاجتنا إلى إعداد أنفسنا للصلاة بالصوم، وحاجتنا إلى
الاستغراق في الصلاة. الصلاة، في عمقها، ذِكر لاسم يسوع. واسم يسوع إيقونة لحضوره. ندعو باسم الرب لأنّنا نرغب في أن ندخل معه في علاقة.
الله نناديه فيقول هاءنذا! لكن الصلاة ليست كلاماً. الصلاة، أساساً، حركة قلب. القلب ينادي القلب. لجّة تنادي لجّة. لذلك الكلام الموجّه إلى الله ينبغي أن يكون نابعاً من القلب، من نقاوة القلب، من سلامة النيّة. إذا كان يسوع لا يجيب فلأنّ في موقفنا منه شيئاً فاسداً. القلب الخاشع المتواضع لا يرذله الله. الله دائماً في الانتظار. يريد أن يلاقينا. لا يكلّمنا إذا كنا لا نعامله كحضور.
لذلك يتقدّم خوفُ الله على الكلام إليه. الإحساس بالحضرة الإلهية أولاً. وطالما الله حاضر فثمّة رعشة أمامه، رعشة سرّية أكبر من عقولنا. هذه تأتي من حضرة وتأتي من التماسنا لهذه الحضرة. رعشته تسري فينا إذا ما اهتممنا بالوقوف أمامه. ونحن نقف أمامه بالوصيّة. نتّبعها. السماع عندنا سمع وطاعة.
الوصيّة حين نسمعها إذا لم نشأ أن نسمعها بهذه الروح لا تنفعنا ولا تبثّنا حضرة الله. نتعاطى الوصيّة لا ككلام بل كمتكلّم يبثّنا نفسه في كلام، يبثّنا مشيئته، روحه.
حين يعطيني أبي الكلمة فكلمته في وجداني حاملة لحضوره. أسمعها، أقبلها لأنّه هو حاضر فيها أولاً، حاضر في وجداني.
لذا كان الكلام الإلهي إيقونة لحضور الله السرّي، الحضور الذي يفوق كل عقل. طاعتي لكلامه طاعة له هو. في هكذا موقف يصير الله حاضراً وأقف أنا قدّامه ويجيبني. طالما أتعاطى وصاياه كنصائح فوصاياه لا تنضح بحضوره. لذا أقرأ الوصايا الإلهية صلاتياً أي كحضور إلهي أولاً.
من هنا أنّنا لا نستغرب ما كان يفعله القدّيس سيرافيم ساروفسكي أنّه كان يقرأ الكلام الإلهي كصلاة. كان يقف منه موقف صلاة بخشوع أو راكعاً. هكذا بحرارة النفس حين أتناول الكلام الإلهي كإيقونة لله يبثّني الله نفسه حضوراً. الله أقرب إلينا من حبل الوريد.
فحين لا ألقاه في نفسي فلأنّ ثمّة خللاً في موقفي منه. الله حضوره فوري وسريع لأنّه الحاضر في كل مكان ولأنّه السريع الإجابة. بكلمة، بموقف، بحركة قلب يحضر. الإنسان تناديه بالصوت المرتفع، برسالة، بحركة قوية، أما الله فبحركة قلب يستجيب، بصراخ من الأعماق الكيانية. لذا القلب الخاشع المتواضع لا يرذله الله.
وأحياناً كثيرة لا تحتاج لأن تقول شيئاً. لا تحتاج إلى الكلام. فقط تقف قدّامه فيراك. تقف قدّامه لا بجسدك بل بروحك.
ألم يكن هذا موقف زكّا؟ وقف قدّامه في الجميزة على بُعد. رآه في الروح قبل أن تقع عينه عليه بالجسد. وقف منه زكّا موقف صلاة. ولا شك أنّه كان له في قلبه لهف. تلك الحركة البسيطة.
ذاك الانعطاف اللطيف كان كافياً ليجعل السيّد كلّه يقف قدّام زكّا ويناديه. أسهل ما في الدنيا الصلاة حين يكون القلب خاشعاً متواضعاً. الله يحضر فوراً. إذا كانت الصلاة لا تصل إلى الله فإنّ ذلك لأن القلب ما زال بعيداً عن القلب. لا زالت هناك غباشة، عدم استقامة. الشفافية تنقصنا. في موقفنا خلل. لا زلنا نتعاطاه كفكرة عابرة. حالما يرتعش الكيان بالإيقونة، بالكلمة الإلهية، يكون الله قد سبقنا وحضر.
هو يعرف أساساً ما سيحدث لذلك نلقاه أبداً سبّاقاً. نلقاه في انتظارنا. لا نأتيه نحن أولاً. يكون هو في الانتظار. لذا تنقية القلب، سلامة النيّة أولاً. كالأطفال. بلا شك. بشيء من العفوية.
لذا كان لا بدّ للنفس أن تتعب، أولاً، من كثافة روح العالم، من كثافة الخطيئة. اللهف، بعامة، يأتي من الوجع. لذا الوجع يشفي. علامة مرض هو من جهة ما هو للجسد لكنّه علامة شفاء من جهة ما هو للنفس. الموجوع، في الحقيقة، هو مَن كان في طريقه إلى الشفاء.
ليس ما يرقّق النفس كالوجع. الإنسان بحاجة لأن يتّكئ إذا كان متألماً. هذه شيمة السقوط. أن تكون معافى في الجسد وكل أمورك ميسّرة لا ينفعك وليس من بركات الله ولو حسبت كذلك. إذا أردت أن تبحث عن الله فابحث عنه في مغاور نفوس الموجوعين والمستضعَفين. لذا كان الله نصيب المكسورين. هنا بالذات يكمن سرّ حضور الله: في النفس المكسورة!
الصوم هو، بالضبط، أن تختار أن تبقى على شفا الحاجة إلى الله، على شفا الوجع. نحن لا نسرّ بالآلام والضيقات كمَن يستلذّ الوجع. هذا مرض. لكنّنا نجعل أنفسنا في موقع الحاجة إلى الله. لا يتراءى الله لنا أولاً إلاّ كحاجة: دواء للمريض وخبزاً للجائع وماء للعطشان.
بعد ذلك، بعد أن يطعمنا إثر ثلاثة أيام الجوع، من الخبزات الخمس والسمكتين، يَفيض علينا خيرُ الله. يُبقي لنا اثني عشر سلاً من الكسر. ومن ثمّ يعطينا، بعد عطش، لا أن نرتوي وحسب بل أن تجري من بطوننا أنهار ماء حيّ.
من أجل هذا تصوم الكنيسة. الإنسان بعد السقوط كائن صوّام. بصومه يقف في الكيان أمام ربّه، يستصرخه، يستدعيه. الصوم، في نهاية المطاف، أن ترفض تعزيات هذا الدهر لأنّها تلقيك في الأوجاع والأحزان. تلقيك في الفراغ الكبير. الفراغ الذي فيك لا يملأه إلاّه هو. لذا تجعل نفسك في الصوم وتشدّ نفسك إلى الصلاة. تدخل الصحراء من تلقاء نفسك فتَلقى في قسوتها لطفاً ولا ألطف.
لم يُدخلْ الربّ الإله الشعب العبراني إلى أرض الميعاد إلاّ عبر الصحراء، عبر الشظف، عبر الضيق، عبر الألم. هذه كلّها أبقت العيون والأفئدة مشدودة إليه.
يوم يشبع الإنسان تنشدّ نفسه إلى البطر والبطر يشدّه إلى عدو الخير وعدو الخير ينفخه ويقيم له نفسَه صنماً. يشاؤه أن يكون إلهَ نفسه. أما الصحراء، صحراء الصوم والصلاة، فتذيقك، عن إرادة، طعم التراب، مرّ العدم. إذ ذاك تميّز المنّ السماوي متى أتاك وتعرف حلاوة الصليب إذ يُلقي موسى شجرة الصليب في المياه المرّة.
هذا كلّه كان تمثيلاً لسيرة حياة جديدة. فقط في هكذا مناخ يحضرك ربّك ويحضرك بقوّة. يصبح لغتك الجديدة، خبزك الجديد، ماءك الحلوة. لا تعرف كيف! لكنّك تلقى أطايب السماء تأتي وأنت في عمق الجحيم ولا تيأس. لا بل الجحيم، ما هو جحيم في عيني الناس، يصير لك أرض الخيرات السماوية. هذا هو الحجر الذي رذله البنّاؤون وصار رأساً للزاوية.
هذا هو الفرح الذي يأتيك في الأحزان والعافية التي تأتيك بالأوجاع. لذا جاءت الكلمة في إشعياء "كعِرق في أرض يابسة نبت... لا صورة له ولا جمال... ولا منظر فنشتهيه. محتقر مخذول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن... محتقر فلم نعتدّ به..." (53) هذه ليست صورة عبد يهوه وحسب، هذه صورتي وصورتك.
هذه نكون إيّاها أولاً ثمّ يأتي الكلام: "مَن تعب نفسه يرى ويشبع... لذلك أقسم له بين الأعزّاء ومع العظماء يقسم غنيمة من أجل أنّه سكب للموت نفسه وأُحصي مع أثمة"... (53).
يوم نحمل نير الصوم بهذه الروحية لنسير في إثر عبد يهوه المضروب، المذلول، المجروح ولا نفتح فاهاً يومذاك تأتي الصلاة كاستحضار دائم لحضرة الله. هذا يجعلنا نفهم كلام مَن قال: "إن تفعل الصلاة طويلاً يشعر المرء، داخل نفسه، بالفردوس" (الرسالة 2. الشيخ يوسف الهدوئي).
ونفهم أيضاً قوله: "إذا لم ترَ دموعاً تنسكب كلّما تذكّرت الله فأنت تعاني من الجهل" (الرسالة 6). وكذلك قوله: "متى تنقّت الحواس... يشتعل القلب بالحبّ الإلهي فيهتف أمسك عني، يا يسوع، أمواج نعمتك فإنّي أذوب كالشمع" (الرسالة 48)